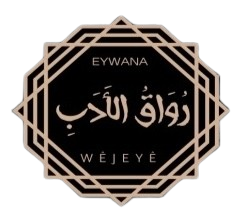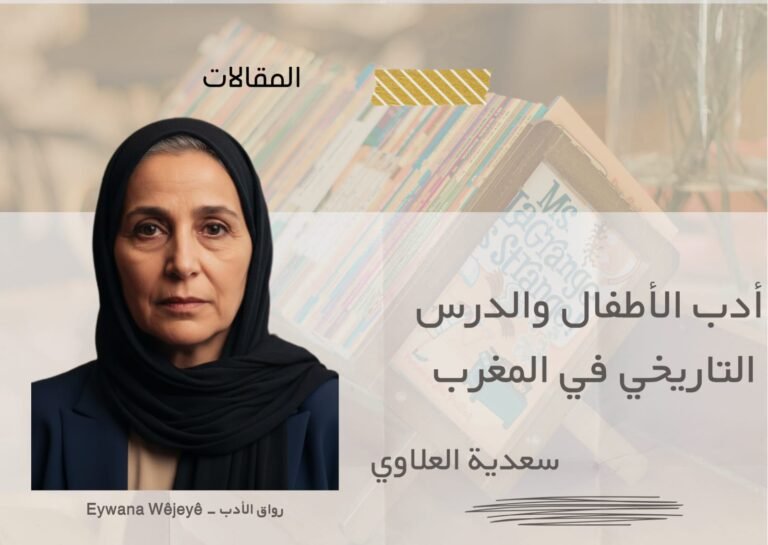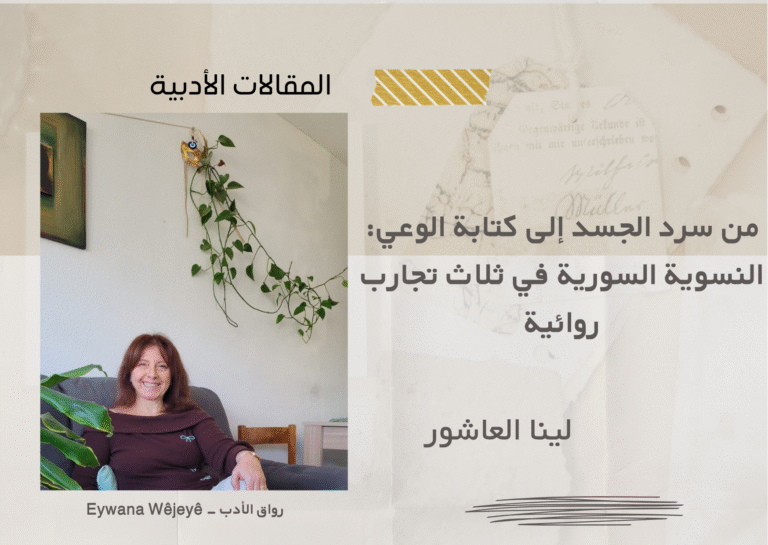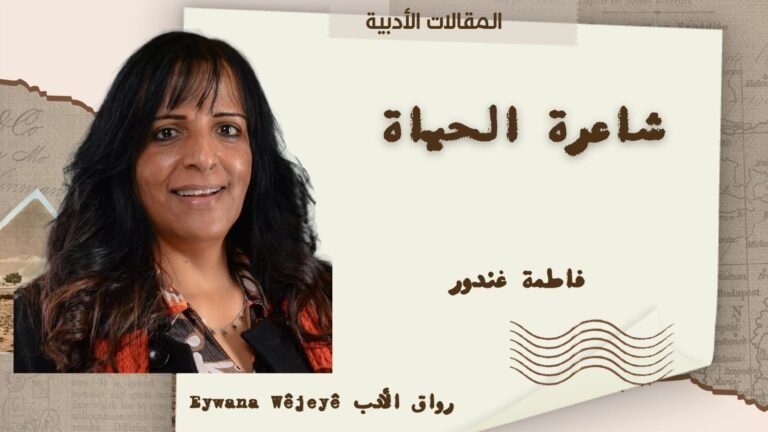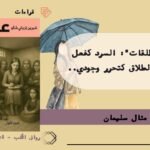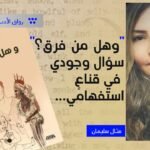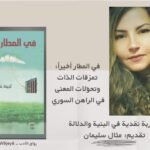ماذا تقدمُ الفلسفة على طاولة العلم؟
گيلان محمد*
المتأملُ في عودة الفلسفة إلى دائرة الأضواء والحراك الذي يشهدهُ المسعى التوظيفي لأفكار الفلاسفة واستعادتهم في المحن الوبائية والبيئية وهم منتمون إلى عصور تاريخية سحيقة.لايسعه إلا أنْ يبحثَ عن العوامل الكامنة وراء هذا الزخم الاحتفائي ،ورصد الهموم التي من المتوقع أنْ تكون ضمن الاشتغالات الفلسفية في المرحلة الراهنة.ومايستدعي مناقشة هذا الموضوع هو الطفرات التي يحققها الحقل العلمي والاحتمالات القائمة بشأنِ مصادرة الذكاء الاصطناعي لمهمة التفكير وتفوقهِ على العقول البشرية.ماذا يمكن للفلسفة أنْ تقدمه على طاولة يتصدرها الجدل العلمي؟ هل يناسبها دور المراقب من البعيد؟ ألم يعترفْ ألفريد نوريث وايتهد بأنَّ الفلسفة الأوروبية عبارةُ عن سلسلة من الهوامش على فلسفة أفلاطون؟ فيما يمضي العلمُ في إضافة فتوحاتٍ جديدة إلى رصيده ولايمكن القول في المجال العلمي بأنَّ فيزياء الكم هامش على ماتوصلَ إليه بطليموس.يرى ستانلي فيش بأنَّ الاستنتاجات التي يتمخض عنها السجال الفلسفي لاتجدُ لنفسها طريقاً خارج سياق المشاركين في الندوات الفلسفية.وغالباً ماتكونُ محصلةُ تلك النشاطات دون سقف المتطلبات الواقعية .هل نفهمُ بُناءً على ماسبق ذكره
بأنَّ كلامَ بعض الفلاسفة أمثال ريشتارد روتي الذي صرح بأنَّ العالمَ لن ينقذه إلا الشعر وأمنية جون ليزلي بأنَّ يكون روائياً إشهار بأفول الفلسفة ونفاد صلاحيتها وتهالك أدواتها ؟ وإذا كان ما يؤجلُ موت الفلسفة هو المنطقة التي يغلفها الموت ومايعقبهُ بالغموض هذا إضافة إلى تحديد الغاية من الحياة فهنا يتقاطع المبحث الفلسفي مع الدين.إذن ما الفرق بين العقلين الديني والفلسفي طالما يشتركُ الإثنان في الانشداد نحو المجهول؟ ولايهمُ الاختلاف في المصدر بهذا الصدد بقدر ما يجبُ الانتباه إلى تربةٍ تضربُ فيها جذورُ الفلسفة والدين.وإذا سلمنا بصحة مقولة وايتهد عن كون نصوص الفلاسفة اللاحقين حاشيةً على المتن الأفلاطوني فلابدَّ من الإقرار بوجود صورةٍ مشابهة لمنطق تعاقب زمني للرسالات الدينية.ومن المعلوم أنَّ هذا الموضوع متشعبُ ولايصحُ التصدي له على هامش نقاش حول موقع الفلسفة في حلبة التحديات المُعاصرة.
التجاور
الملاحظُ في هذه الموجة الفلسفية المتزامنة مع تصاعد المغامرات النوعية أن روادها ينتمون إلى بيئات تفورُ باكتشافات علمية.وتحتضنُ عقولاً تجوبُ بقارات معرفية جديدة.إذن يتجاورُ العلمُ والفلسفة ويبدو بأنَّ الأولَ لايلغي وظيفة الثاني.ولايكون له بديلاً.ومن البداهات التي لاتحتاج إلى التذكير أنَّ الثابت في المختبر الفلسفي هو الشك، لذلك من حق أي متابعٍ النظرُ في منحى الفلسفي السائد.والقبض على الآلية التي يستجلي من خلالها أوجه القصور لأنَّ الفلسفة ملطخة إلى الأبد بقصورها الخاص على حد تعبير “كريستن دايفس” إذن ماهي طبيعة الأفكار التي تشكلُ أمزجة المدشنين للمشروع الفلسفي الحديث؟في الواقع أن المصادر التي تضخُ الدماء في أروقة الفلسفة وتعيدُ الحيوية إلى المسلك المعرفي متقاربةُ كذلك فإنَّ الغاية من التناول الفلسفي لاتختلف كثيراً من مفكر إلى آخر،كماإنَّ إدراك ما يكتسبهُ أصحاب مدرستي الرواقية والأبيقورية من الاهتمام و الأولوية في أجندة المفكرين المُعاصرين لايكلفك عناء ذهنياً.ومعنى ذلك إن البعد العملي هو ملعب النشاط الفلسفي ،وبالتالي لايعقلُ الانجرار وراء شعار المعرفة من أجل المعرفة،ولاتجدي الرطانة اللفظية نفعاً في إعادة ترتيب الأوراق على الصعيد الواقعي.ويذكرُ أنَّ الملمح الأبرز في البرنامج الفلسفي بنسخته الجديدة هو التخفف من عبء المشاريع الكونية الموعودة ربما يُحملُ على هذا النفس غير الخلاصي ويُحاكمُ على اعتبار أنَّه هروبُ من هموم النظير الإنساني.أياَّ تكن الأحوال فما هو واضح أن الحل النهائي لايلوح في الأفق.يعترفُ الباحثُ الأمريكي كيران سيتيا في كتابه “الحياة صعبة” بأنَّه ليس هناك علاجُ شافٍ للوضع الإنساني لكن بعد عشرين سنة من تدريس ودراسة الفلسفة الأخلاقية يثقُ بقدرة هذا المجال على مساعدة العقول الواقعة بين نيران الأزمات. طبعاً الفلسفة الأخلاقية تتسع لجميع جوانب الحياة.ويشيرُ سيتيا إلى رأي أفلاطون في هذا الإطار “لايدورُ الحديثُ هنا حول موضوع عادي بل يتناول الطريقة التي يجبُ أن نعيشَ بها” وماينبغي التحوط منه هو الخلط بين الرؤية الفلسفية للعيش وما يسوقُ له تحت غطاء الحكمة فمن المعروف أنَّ ثمة من يبذرُ في إسداء الأوهام الدفينة في قشرة الفلسفة،أو يريدُ التبرير للمعاناة الإنسانية.وهذا أسوأ ما يمكنُ أن تسمعه تعقيباً على المحن التي تداهم الحياة البشرية.لأنَّ الإشكاليةَ أعقد من أن تنتهيَ بكلامٍ مجاني وربما لايوجدُ أي تفسير مقنع مقابل هذه المواقف.كما أنَّ المرجعيات الفكرية والعقائدية تلعبُ دوراً في فهم الظواهر والتحديات الوجودية لذلك يعلنُ كيران سيتيا بأنَّه لايبحثُ عن رهانه خارج العالم المرئي مبدياً قناعته بمبدأ الروائية والفيلسوفة آريس مردوك “لايمكنُني الاختيار خارج العالم الذي أراه ،بالمعنى الأخلاقي لكلمة أراه الذي يحفز الخيال الأخلاقي والجهد الأخلاقي.ومن ثمَّ يؤكدُ بأنَّ مايوجهنا في الحياة ليس الجدل والنقاش بل التوصيف وهنا لاتحيدُ الفلسفة عن خط الأدب والفن والتاريخ والمذكرات.وهو بدوره يبني استراتيجته في الكتابة على المعطيات المتعددة هذا فضلاً عن تجربته الذاتية ولايختلفُ في ذلك عن رصفائه الفاعلين في نادي الفلسفة أمثال فريدريك لونوار وستيفن نادلر ووليم ب.إرفين.
اللا استقطاب
قد لايحسبُ القول في خانة الشطط بأنَّ المنهج الفلسفي بنسخته المتداولة لايقومُ على المستند الاستقطابي ومردُ ذلك هو غياب النفس الآيدولوجي والحال هذه لا استغراب في وجود المرجعيات المشتركة بين الباحثين والمفكرين إذا طابقت بين مانشره إرفين بعنوان “دليل إلى الحياة الكريمة “ المُستلهمة أفكاره من الفلسفة الرواقية وما ينهمكُ عليه كيران سيتيا لصياغة وصاياه الفلسفية الكاشفة لطريقة الحياة.تقعُ على مثابات فكرية متجاورة ومايحددُ خريطة الكتابين هو الاشتغال على الأهواء والانفعالات إذ يفردُ سيتيا الفصل الأول للبحث عن الهشاشة ويضربُ مثالاً بصيغة افتراضية للإبانة عن مساحة اللامتوقع في الحياة.ومن جانبه يتناول إرفين في كتابه مايصطلحُ عليه بالتخيَّل السلبي وهنا تجد لدى الاثنين مقتبساً من “المختصر” لأبكتيتوس الذي يرى بأنَّه من المفيد بالنسبة للمرء أن يتخيل ضياع الأشياء التي تهمه حتى يتخففَ الشعور بالصدمة عندما تضيع فعلا. فعلى سبيل المثال أتوقعُ بأنَّ الملفات المخزنة في الحاسوب قد تتلف .وبذلك لايكون ردُّ فعلي عنيفاً حين لا أعثرُ على ما كتبته. واللافت للنظر في منهاج الباحثينِ هو الاهتمام بمفهوم التضامن الإنساني ويتابعُ سيتيا هذا الموضوع بالتفصيل عاداً الآيدولوجيات التي تشويه الوسط الاجتماعي وتعرف الحياة وتصنف الناس إستناداً إلى ثنائية النجاح والفشل سبباً لاندثار الروحية المُتعاطفة في العالم ،والجانب الأكثر أهمية في متابعته لهذه الإشكالية يتمثل في رصد تبعاتها النفسية . يقرُ المؤلفُ بأنَّ الفلسفة قد لاتقنعُ المرءَ بضرورة مؤازرة الآخرين في غياب الاستعداد الذاتي والإرادة المبادرة غير أنها تساعدنا على فضح الظلم. بالمقابل يستعيدُ إرفين في كتابه ماقاله ماركوس أورليوس بشأنِ مايجب أن يمتسك به الإنسان الرواقي من المرونة الوجدانية في سلوكياته مع الآخرين.
أرق المعنى
ومن المواضيع التي أضيفت إلى المأدبة الفلسفية هو البحث عن المعنى ومايجدرُ بالذكر أنَّ هذه المادة جديدُة على المعجم الفكري قياساً على المفاهيم التي شغلت العقلية الفلسفية منذ انطلاقتها الأولى إذ ظهرت عبارة “معنى الحياة” سنة 1834 في رواية “فلسفة الملابس “ لتوماس كارليل.لكن ما لبث أن تسرب المصطلح إلى الأدبيات الفلسفية وكرس المؤلف البريطاني آلان دوبوتون أخر إصداراته لدراسة العناصر التي تُعمق الشعور بالمعني وتخففُ من أرق الخواء الروحي .وفي الواقع أنَّ التشكيلة المطرزة على مائدة دوبوتون منتقاة بذوق رواقي وقد يختصرُها مقترحُ الفيلسوفة زينا هيتز الذاهب إلى “الشغف بالأشياء الإنسانية البسيطة” ومايساورُ المراقب للإشكاليات الحياتية أنَّ كل هذه المعاناة هي نتيجة للوجود غير أنَّ الحلَ لايكمن في نقيض ماهو موجود لأنَّ اللاوجود قد يكون مصدراً لاستياء أكثر.ومن نافلة القول بأنَّ السؤال عن معنى الحياة يبدأُ عندما يثقلُ الحزن وطأته على الروح ويعتقدُ آينشتين بأن الأجابة عن سؤال مامعنى الحياة لابَّد أن تنطوي على دين ما. إلى هنا ربَّ من يعترض على المحاولات الهادفة لنحت دور جديد للفلسفة لافتاً إلى ما أكد عليه ستيفن هوكينج بأنَّ من لايجيبُ عليه الفيزياء ليس موجوداً.ومعنى ذلك أن الطريق مسدود ولا صوت يعلو على صوت العلم .هل نحن أمام احتضار اللجظة الفلسفية ؟ نعم الفلسفة بنسختها المؤسسية لم يعد لها موقع على خريطة الأزمات البشرية أما الفلسفة بوصفها جزءاً من الاشتغالات الفردية وأداة للنقد واستنهاض الفاعلية الفكرية تغدو اختياراً مناسباً لصياغة الحكمة الشخصية لأنَّنا كما يقول أندريه كونت سبونفيل يمكن أن نصير علماءً بعلم الغير لكن لانكون علماءً إلا من حكمتنا الخاصة.على هذا المستوى لن تجد بديلاً للفلسفة سوى الفلسفة.و من يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيرا.لاينكرُ أحد بأنَّ العلم بلغ شأواً كبيراً في الذكاء ولكن هل يكون الذكاء رديفاً للإبداع دائما؟ يقولُ آينشتين :- “الإبداع هو أن يكون الذكاءُ متعة “.