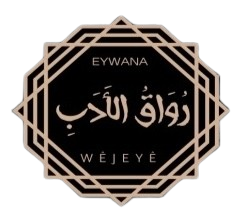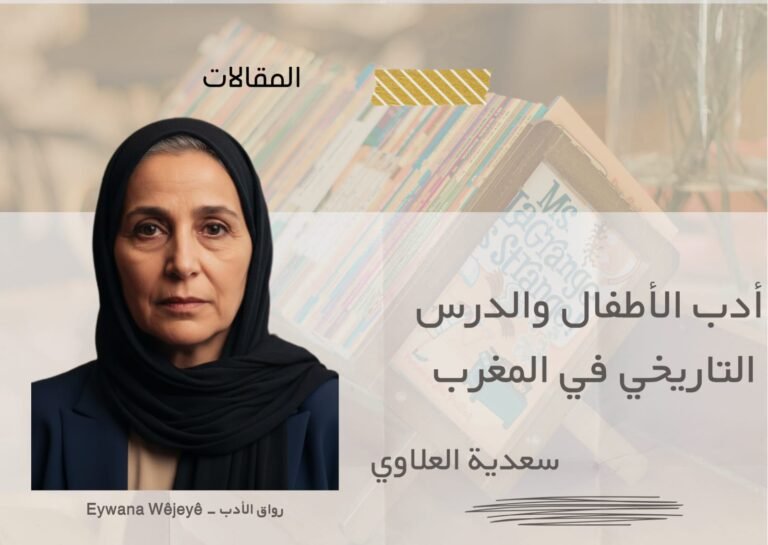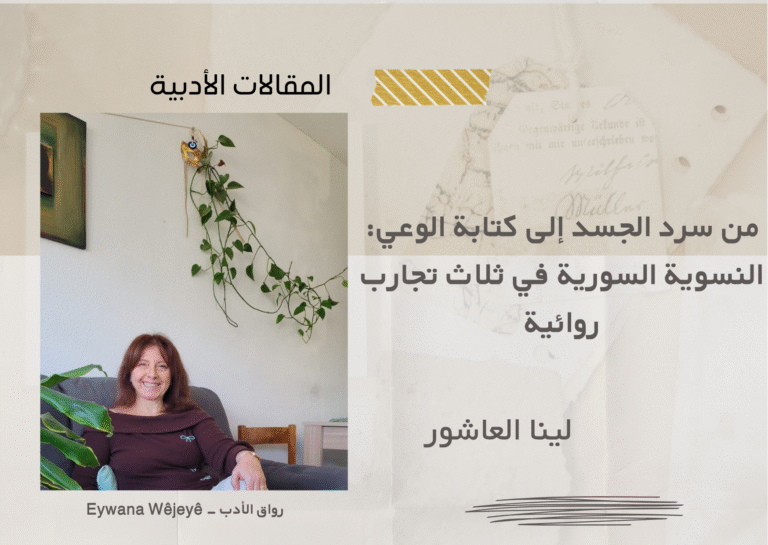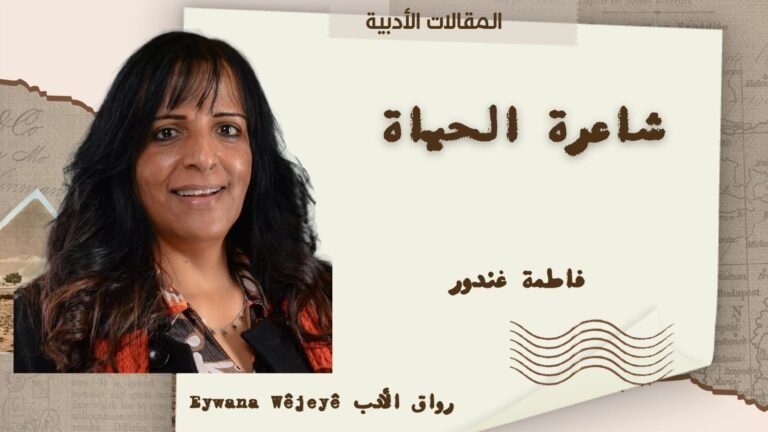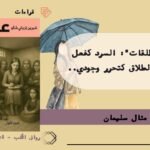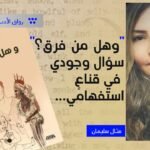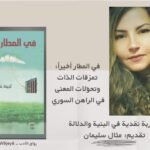فاضل متين/ أقليم كردستان
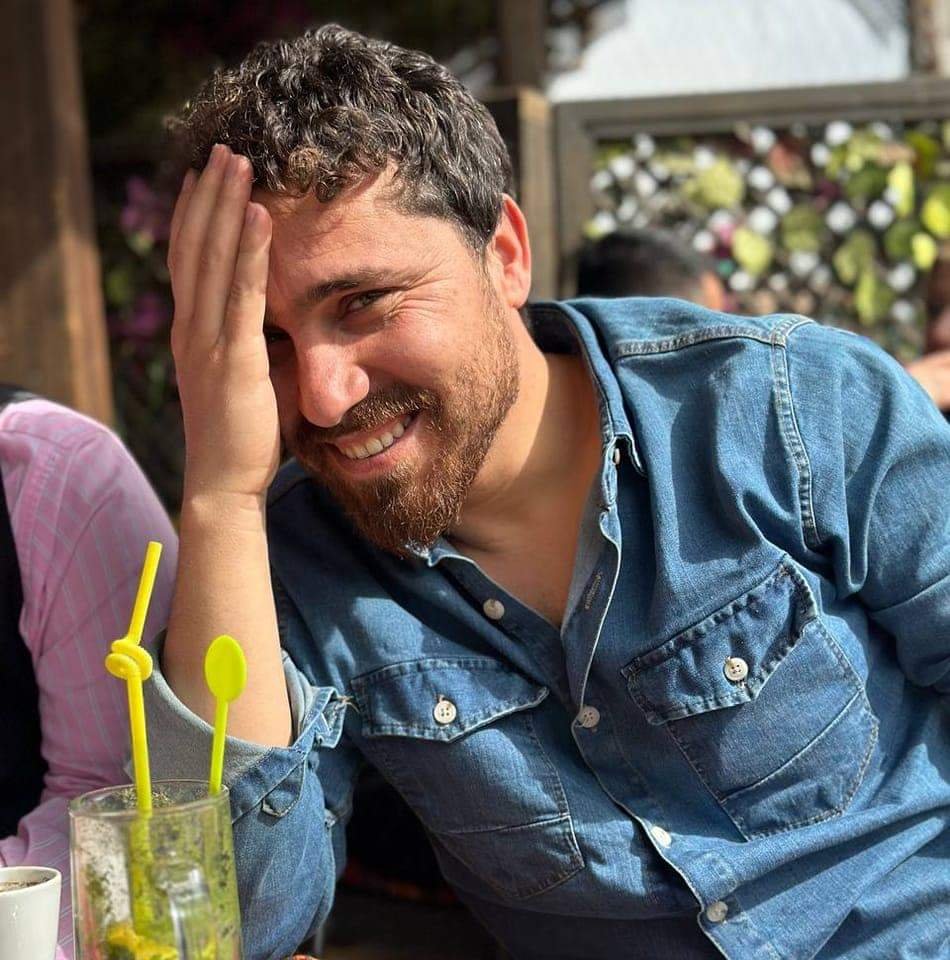
“أنا كُردي. نعم. أستطيع الكتابة عن روحي بألف لغة. لكن، حين تحاول لغة واحدة من هذه اللغات أن تفرض قيداً على كرديتي، آنذاك يبدأ المنفى، هنا أو هناك، في الجحيم التي تتخذها السُّلطة “قانوناً” لإلغاء الفروق.
إن اللغة العربية، بالنسبة إليّ، إثراء هائل لهويتي الكردية. وهي “الحرية” التي يُقَدّم بها ألمي اعترافه إلى المكان” ..(1) سليم بركات
أنوء تحت عبء همّ لغتي، لغتي المعتقلة في سجون قدرها، وإذا كانت هي أسيرة فكيف سأستعين بها للتعبير عن الحرية؟ لكن عليّ أن أتكلم، عليّ أن أخبر الآخر عن وجودي كجريحٍ في هويته، كغريق يبتلعه بحر الغياب، إن الهرب لكلا الجهتين منفى، الصَمتُ منفى والكتابة بلغة الآخر يعتبر نفي إلى لغته، فهل أُبقي نفسي أسيراً معها وأركن للصمت أم أرفع بانكسارٍ طلب اللجوء إلى لغة الآخر ولو على مضضٍ؟.. يقول لسان حال الكاتب الكردي السوري.
بين فترة وأخرى يطرح على الساحة الثقافية موضوع مستفز يخص ماهية الكتابة التي يكتبها الأدباء الكرد بلغة الآخرين، موضوع اُستثير في السنوات العشرة الماضية التي عثرت فيها اللغة الكردية منفذاً لتتنفس عبره بدون أي خوف أو خشية من أية سلطة جائرة، إذ استعادت
شيئاً من حقها كلغة حقة، ومع بداية تحررها اندفع بعض المهتمون إلى إعادة النظر في الأدبيات الكردية المكتوبة باللغة العربية وتباحثوا في أصل جيناتها( هل هي أدبيات كردية أم عربية؟) ..
لا يخفَ على كل متابع بالآراء الكثيرة التي أدليت بشأن هذا الموضوع والنقاشات التي جالت حولها من قبل المثقفين الكرد، أن يرى أن هناك فريقان ينتصر كل واحد لرأيه. الفريق الأول يرى أن مضمون النص يعكس هوية النص وليس لغته، والفريق الآخر يحسم الأمر للغة ويراها المعيار الأساسي لتحديد قومية النص. في الواقع يبدو أن كلا الطرفين محقان، فلكي يكون الأدب أدباً قومياً خالصاً يفترض أن يكتب بلغة تلك القومية، لكن من ناحية أخرى نعرف أن مهنة الأدب هي ترجمة هواجس وشجون وجماليات تلك الأمة للعالم، أي أن مهمته نقل رسالة المجتمع، وبالتالي لا يهم بأية لغة أنقل الرسالة، المهم أن يقرأني العالم ويصغي إلى ما أقوله.
من وجهة نظر كثيرين ومنهم أنا نرى أنه يجب أن نفرق بين اللغة وبين الأدب، فاللغة لكي تتقدم وتخطو وتزدهر فأنها بحاجة إلى كيان محمي أو سلطة ضامنة، والأدب إذا لم يجد لغة حرة فإنه سيسعى أن ينمو في لغة غريبة تحظى بالاستقلالية والأمان. لا يتطلب الأمر أن نذكر وضعية اللغة الكردية في ظل سلطة سياسية مستبدة كالبعث العربي، هذه السلطة التي دفعت لظهور مصطلح ملتبس في الحياة الثقافية الكردية “الأدب الكردي المكتوب بالعربية” وهو مصطلح أعتقد أنه مرحلي مؤقت سيزول على الأغلب ما أن تستمر اللغة الكردية في نموها التصاعدي مع مرور الزمن، وسيقيم الأدب الكردي في أرضه، بعد أن حلّ ضيفاً في اللغة العربية كل هذه السنوات- لغة المضيف كما يسميها الدكتور خالد حسين..
قبل أن أبدأ بكتابة هذا المقال اِلتقطت بعض الآراء والتصريحات المتباينة بشأن الكتابة باللغة العربية من بعض مثقفي الكرد، الجميع اتفقوا على أن اللغة العربية كانت لغة فرض وخيار وليست لغة اختيار، ومع الزمن صارت لغة أبوية إلى جانب لغة الأم التي تقطن في المخيلة وتجري على الشفاه.
هيثم حسين الناقد والروائي في حوار قصير معه عن ماهية الأدب ظهر غير عابئ بالتسميات التي تخلع على الكتابات الأدبية، ويرى أن اللغة بالنسبة له ليست المقياس الوحيد لتحديد هوية الأدب :
“بصراحة أحاول دوماً الابتعاد عمّا يمكن أن يوصف بالحسم والفصل والجزم بأنّ هذا العامل أو ذاك يشكّل جنس الأدب، لأنّ الأدب أكثر سعة ورحابة من أن يقيّده عامل محدّد. أتفهّم دوافع ومبرّرات مَن يحصر هوية الأدب
باللغة، ولكن لا أبقي نفسي رهين هذه التصوّرات، ولا أفرض على نفسي أيّة مشاعر تندّب أو تحسّر بأنّ هوية الأدب مقتصرة على لغته التي يكتب بها.. ومَن قال إنّ هوية الإنسان تُبنَى فقط على المكوّن اللغويّ!”(2)
لكن للروائي حليم يوسف عبر مقال له(3) رأيٌ مخالف، إذا يحسم بقوة أن اللغة هي الشرط الأهم والأوحد الذي يحدد جنس الأدب ويكسبه كينونتيه وهويته. ويشاركه في الرأي المترجم المعروف حسين عمر الذي يظهر أقل ليونة في رأيه من حليم يوسف.
الأمر الذي يخالفه الناقد الأكاديمي خالد حسين الذي يميل إلى أن اللغة الداخلية والعوالم والفضاء الذي يؤسس النص تعلن إنتماء النص، ويقول في حوار معه:
“الكتّاب ــ الكرد لم ينصرفوا عن لغتهم ـ الأم إلى العربية أو الفارسية أو التركية عن طيب خاطر وإنما الضغوط الخانقة التي مارستها الأنظمة الاستبدادية هي التي أجبرتهم للاستعانة باللغة المهيمنة (العربية، الفارسية، التركية). وهكذا فالكتابة بالعربية بالنسبة إليّ تدخل في إطار الإرادة المتسلطة قوةً ومنعاً للكردية، أي إرادة الإكراه في اختيار لغة الكتابة.
ــ لتحديد الانتماء الثقافي للأدب ــ وفي سياق هذه المعضلة التي أشرتُ إليها، فأعتقد جازماً أن عاملي الموضوع والعوالم علاوة على زحزحة “اللغة المهيمنة” تحدّد طبيعة هذا الانتماء، وأقصد بمفهوم “الزحزحة” إحداث جرح في اللغة المهيمنة، تطعيمها بهسهسة اللغة ــ الأم وهو ما نجده بالفعل في الممارسات الخطابية التي يتولاها الكتّاب الكرد في التعبير عن عوالمهم وشؤون الكرد وتعريض العربية إلى أسلوبية محددة تشي بكردية الكاتب والمكان الكردي.”(4)
كثيرة هي الآراء المتباينة الجديرة بالاهتمام والمناقشة لكن لا يسع المجال هنا لادراجها جميعاً، غير أنه لا يمكن تخطي ما باح به الكاتب المسرحي أحمد إسماعيل إسماعيل الذي سرد بنبرة حزينة شجون مسيرته في الكتابة، مسيرة تشكل طفل أبدع بلغة الآخر، لكنني أضطررت أن أقتطف من حديثه الطويل جزءاً لا بأس به من رأيه عن المقومات التي تحدد جنس الأدب، وكان رأيه معتدلاً، وأقرب إلى التوازن بين جميع المعايير التي يبنى عليها هوية النص.
“ بعيداً عما يخصني، وقريبا من واقع حالنا، فإنني، ورغم إقراري بمركزية اللغة في تحديد هوية النص، لأنها المادة التي ينسج الكاتب منها وبها جلّ عناصر وعوالم وشخصيات نصه، إلا أن هذا ليس كل شيء، فلا بد من الإقرار بأن هناك عناصر أخرى غير اللغة مثل: التاريخ والاحداث والامكنة والشخصيات والثقافة الشفوية.. تساهم بقوة في تشكيل هوية النص، وكذلك الإنسان والمجتمع، كما أن الهوية ليست معطى ثابتاً ومقدساً. بل مفهوماً حيوياً يتبدل حسب الظروف، ولعل اختزالها في عنصر واحد وحيد هو اللغة، رغم مركزيته، دون عناصرها الأخرى؛ إساءة كبيرة لها.. وخطأ فادح.
وخاصة بالنسبة لشعب مقهور لا كيان سياسي له ولا مؤسسات ولا قاموس لغوي رسمي واحد. ومطالب منه الدفاع على جبهات كثيرة لإثبات خصوصيته ومشروعية وجوده: بالقوة وبالفعل.
والكتابة عن قضيته بغير لغته نضال على واحدة من هذه الجبهات.”(5)
الهوامش: 1 حوار بين سعادة سوداح وسليم بركات الحياة 15_16، 3، 1992.من كتاب لوعة كالرياضيات وحنين كالهندسة. 2 حوار خاص
3 من حوار له في مجلة قناص مع الصحفي جوان تتر ٢٠٢٢م 4 حوار خاص
5 حوارخاص