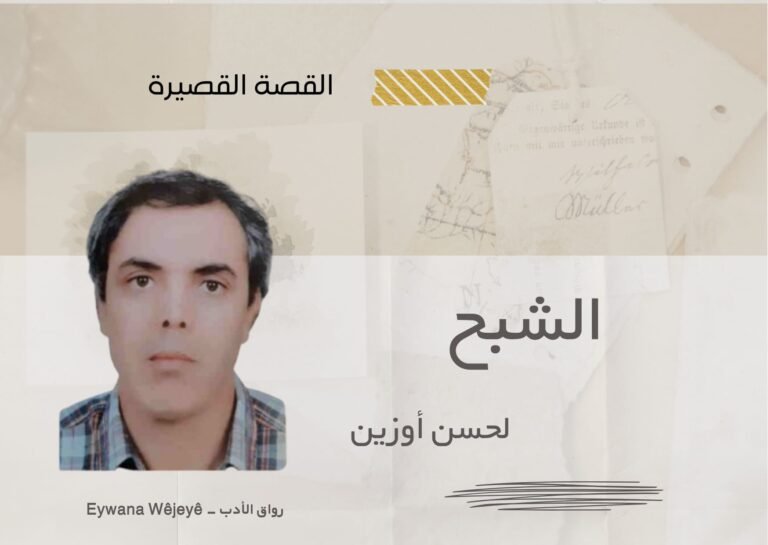مچو ويس

لكثرة ما سمعتُ بزوال كابوس البطش في بلدي، انتابتني لوهلةٍ رغبةٌ جارفة بأن أُقنِع نفسي بالعودة إلى حضن الوطن؛ فحجزتُ تذكرةً وعدتُ على متن الطائرة إلى حيث أنتمي.
في الحي الذي قطنتُه يوماً ما، مشيتُ على قدميَّ مقترباً من منزلي.
قبل الوصول إلى مدخل البناء بخطواتٍ، تذكرتُ أنني سأشعر بالجوع ليلاً وبيتنا خالٍ من قاطنيه منذ سنين، فتابعتُ باتجاه دُكَّان جارنا.
بعد بضع خطواتٍ، تذكرتُ أن صاحب الدُكَّان كان قد غادرَ الوطنَ مثلي – مهاجراً إلى الدانمارك!
ولأنّ الظلام بدأ يُخيِّم، وازداد عدد حاملي السلاح على حساب المارَّة المدنيين في ساحة الجامع الكبير؛ آثرتُ أن أبقى آمِناً على الشعور بالجوع، لذلك عدتُ أدراجي.
عبرتُ أحد المارِّين على الرصيف الذي لم يكن ضيقاً، لكنه كان مشغولًا بثلَّةٍ من المُلَثِّمين، فأومأتُ للمارِّ بكلمة “شكرًا” على إفساحه الدرب لي. لم أسمع ردَّه؛ فقد كان مُسرِعَ الخُطا مثلي.
على إثرِ سماع المُلَثِّمين لكلمة “شكراً”، رَغِبَ أحدهم أن يتباهى بسكِّينه أمام رفاقه مجرِّباً إياها:
“هل أعجبتكم سكِّيني الجديدة؟”
فأخذ يرميها عالياً ويعيد مسك رأسها بإبهامه وسبَّابته، ورحتُ أندُبُ عفويتي وأنا على بعد خطواتٍ من البيت: “لِمَ لم أقل للمارِّ ‘الله يعطيك العافية!’ أو على الأقل ‘يعطيك العافية عَمُّو!’”
وباغتني المُلَثِّمُ برمية سكِّينٍ كادت تُغرَز في أعلى خاصرتي اليمنى لولا أني تنحَّيتُ بجسدي جانباً، فأصاب رأسُها راحةَ يدي اليمنى. وتابعتُ المشيَ كأني لم أرَ أو أسمعَ شيئاً أو أشعرَ بشيء.
ضاقَ الوقتُ أكثرَ ولم أستطع أن أبرِّر عفوية نطقي لكلمة “شكراً”، فجاءت رميةُ سكِّين ثانية من مُلَثِّمٍ آخرَ في صدري لتُخلِّصني من ندمي.