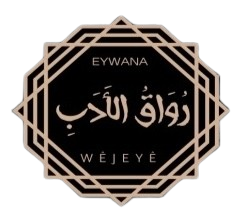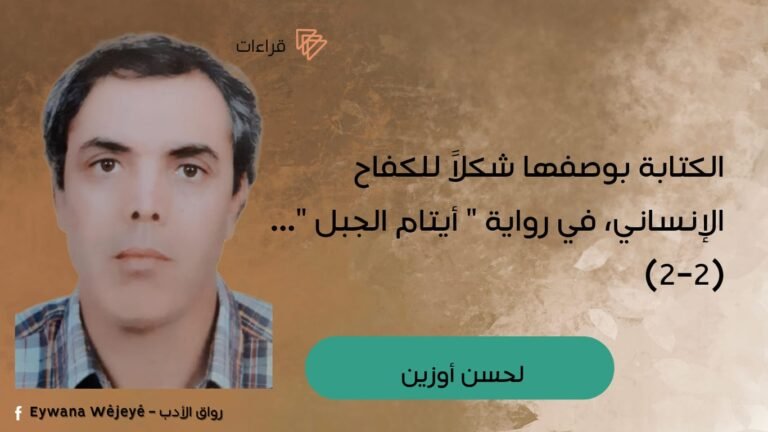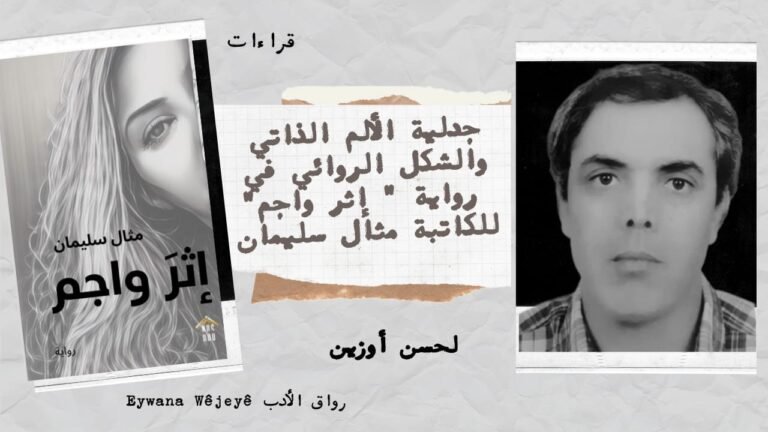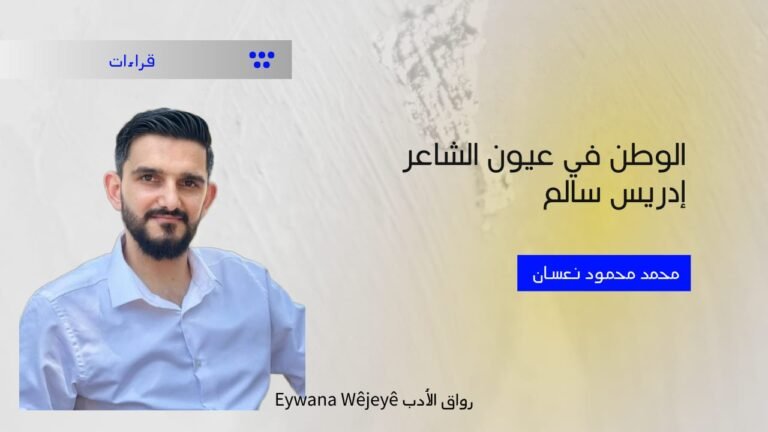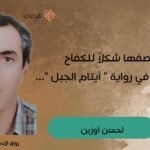مثال سليمان

العنوان/ العتبة الأولى لمداخل النص:
وهل من فرق!؟
يأتي عنوان الرواية بصيغة استفهامية مواربة، تُخفي تحت بساطتها الظاهرية حمولة فلسفية ووجودية كثيفة. “وهل من فرق؟” ليس سؤالاً نترقب منه الجواب، بل هو صوتٌ داخلي يتردّد في أروقة الذات المهزوزة، تساؤل معلّق بين الشكّ والتسليم، بين الفقد واللاجدوى. العنوان هنا لا يطلب الفرق بقدر ما يعلن سقوط المعايير القديمة، وانهيار الفواصل بين ما كنا نظنه متناقضات: الوطن والمنفى، الحلال والحرام، الشرف والرغبة، الانتماء والتغرّب.
إنه استفهام يحمل نَفَس المأزق؛ مأزق الكائن المخلوع من جذوره، المشطور بين ثقافتين، بين منظومتين أخلاقيتين لا تلتقيان، أو لعلّهما تلتقيان في هشاشة الإنسان ذاته. فحين يقول سوار – أو يقول النص من خلاله – “وهل من فرق؟”، فإنه لا يقارن بقدر ما يعلن انسحاق المعنى تحت ضغط التجربة، ويضع القارئ أمام مرآة متصدّعة لا تعكس صورة واحدة، بل شظايا هوية قُذفت في مهبّ الأسئلة.
“وهل من فرقٍ إن توددت لك، أم لم تتودد؟ “
“هناك صديقٌ صدوق وصديق غريب. أيهما كانت ستفضل رفيقا لزوجها؟
وهل من فرق؟ “
“وهل حياة متواضع مثلي مع زوجةٍ أصيلة المنبت مثلها، مريحة أكثر أم العيش وحيداً؟
وهل من فرق؟”ص٦٧
وبهذا المعنى، يغدو العنوان نقطة الدخول إلى بنية الرواية كلها: تردّد، خيبة، استنطاق، ثم مواجهة مريرة مع الذات والآخر. هو أكثر من مفتاح لغوي؛ إنه عتبة فلسفية تقود إلى عمل لا يهدف إلى الحسم بقدر ما يهدف إلى تعرية السؤال ذاته.
رواية البداية التي لا تشبه البدايات:
في زمن تنسحب فيه الرواية أمام سطوة المحتوى السطحي، تخرج رواية “وهل من فرق؟” الصادة عن دار آڤا سنة 2023 للكاتب الكردي-السوري مچو ويس كعمل أول لا يحمل سمات البدايات المرتبكة، بل يتقدّم بخطاب ناضج، مكتمل الوعي، يُمسك بأسئلته الجوهرية دون مواربة. الرواية – الممتدة على 126 صفحة، مقسّمة إلى ثمانية فصول غير معنونة – تنحاز إلى همّ الوجود لا إلى حبكة متشابكة أو معمار بنائي معقّد، لكنها رغم بساطتها الظاهرية، تنفتح على قضايا شائكة تُلامس جرح المنفى، وتشظيات الذات، ومأزق الهوية في مجابهة الآخر.
الذات المنفية ومرايا الانكسار:
يتتبع العمل سيرة “سوار”، اللاجئ الكردي الخمسيني، الذي يتنقّل من الرقة إلى كوباني، ثم أوروبا، دون أن يغادره الشرخ الداخلي. فالرواية ليست سيرة لجوء بقدر ما هي تأريخ للانكسار النفسي، لحياة تتآكل بين مفاهيم لا تنسجم مع ذاتها. في أوروبا، يجد سوار نفسه في مواجهة مرايا لا تعكس ماضيه فقط، بل تُعيد مساءلته: ماذا تبقى منه؟ وما الذي تغيّر فيه؟
“اليوم، البارحة، قبل يومين، قبل ثلاثة أيام، قبلها بيومٍ آخر، وآخر، والآن، كلها مختزلةٌ على هيئة شريطٍ بياني، وكأنه تخطيطٌ لقلب ما، شريطٌ مستقيم كطرقات الأراضي المنخفضة هذه، لا جبال، لا هضاب، لا وديان، لا فوضى مثيرة”.ص ١٠٩
بنية تيار الوعي1: كتابة العطب النفسي:
العطب الذي كان نتيجة هشاشة الذات وتصدعها بُعيد الحرب وفي المنفى. توظف الرواية تقنية تيار الوعي بوصفها استراتيجية سردية تسمح بالغوص في الطبقات العميقة للذات. فبدل الاكتفاء بالحكاية الخارجية، تُنصت الرواية إلى الصوت الداخلي للشخصية، مُدخلةً القارئ في زمن نفسي متقطّع، حيث الحاضر والماضي يتواشجان عبر فلاش باكات متكررة. مشهد فتاتين( إيڤا و إيڤونا) تتبادلان القُبل في أمستردام، مثلًا، لا يبقى مجرّد واقعة بصرية، بل يتحوّل إلى مدخل لنبش مكبوتات الطفولة، حيث يتقاطع الخوف مع الرغبة، والدهشة مع الشعور بالذنب.
هكذا تتحوّل الرواية إلى مسرح داخلي للتمزّق، حيث الذات الشرقية تجد نفسها فجأة في فضاء حرية لم تكن مهيّأة له، فتتأرجح بين الانبهار والضياع.
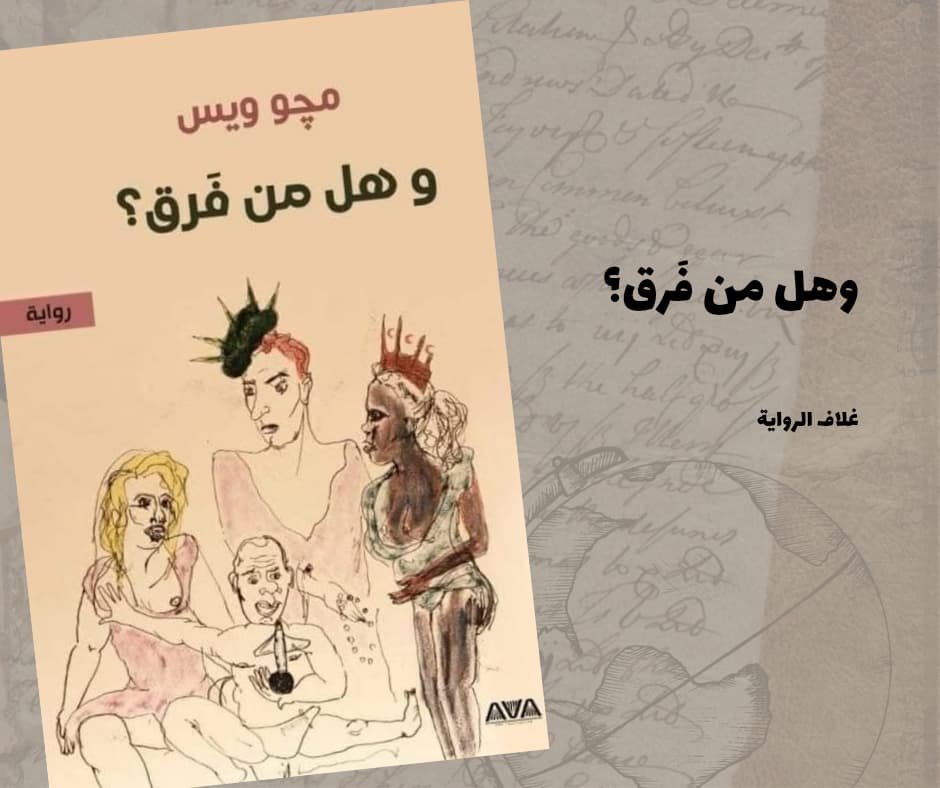
سؤال الاندماج والانمحاء: سوار وصبري كنموذجين:
يعمّق ويس الطرح عبر مفارقة سردية بين شخصيتين: “سوار” الذي اختار نوعاً من التكيّف مع المجتمع الجديد، و”صبري” الذي ظلّ وفيًا لقيمه القديمة، حتى تهاوى زواجه وانكسر في لجوئه، فعاد إلى وطنه المنكوب. هنا لا يُقدَّم الاندماج كخلاص، ولا الانكفاء كإدانة، بل يُطرح المأزق الوجودي: هل يمكن للاجئ أن يندمج دون أن يفقد هويته؟ وهل العودة إلى الوطن المنكوب فعل نكوص، أم محاولة لاسترداد الذات؟ الرواية لا تجيب، إنما تُبقي السؤال مفتوحاً على احتمالات مريرة.
الجسد بوصفه خطاباً ثقافياً:
تبلغ الرواية أقصى جرأتها في مشهد العلاقة الجسدية بين سوار و”بيترا”، زوجة الهولندي الذي يقبل بهذه العلاقة دون اعتراض. هنا لا يُوظَّف الجنس كعنصر إثارة، بل كأداة تحليل ثقافي. في تلك اللحظة، يتواجه مفهومان متباينان عن “الشرف”: الشرقي المقموع، والغربي المتحرّر، لتطرح الرواية سؤالها الأشد مرارة: هل نحن أكثر تمسّكًا بالقيم، أم أكثر نفاقًا؟ وهل الغرب متساهل فعلًا، أم أكثر صدقاً مع تناقضاته؟
لكنّ هذا الطرح، رغم جرأته، لا يخلو من انتقائية، إذ أنّ الرواية تُقدّم الغرب من زاوية جنسانية ضيقة، وتغفل تعقيدات بنيوية أعمق، كالقيم الديمقراطية، أو الفكر النقدي، مما يُضعف التوازن في تمثيل الآخر وتذويب الذات الهشة في بوتقة الحرية المغلوط فهمها.
اللغة والأسلوب: بين الصدق والبُطء:
اللغة في “وهل من فرق؟” لغة واقعية، تميل إلى التقرير والوضوح أكثر من الانزياح الشعري، لكنها تحتفظ بقدرة سردية على تشييد المشهد بلغة حميمة. ومع ذلك، يقع النص أحياناً في فخ الإطالة، خاصة في المشاهد الوصفية (منزل بيترا، مزرعة صبري ومقابلة العمل)، مما يُربك الإيقاع ويُضعف التوتر السردي. كذلك، هناك بعض العناصر التي لم تُوظّف درامياً بفعالية (مثل مشهد حلمه وهو صغير، جلوسه في المقهى، أو دورية الشرطة)، فتبدو إضافات هامشية أكثر من كونها ضرورات بنيوية.
الطلاق والمرأة: جدلية الحرية والانفصال:
في خلفية السرد، تُطرح مسألة الطلاق في مجتمعات اللجوء، لا سيما عبر حكاية صبري وزوجته. في الشرق، يُعَد الطلاق وصمة، خصوصاً للمرأة، بينما يتحوّل في أوروبا إلى قرار فردي. الرواية تلمّح، لا تُصرّح، بأن هذه الحريّة قد تكون – أحياناً – ذريعة للإصلاح، لتضعنا أمام سؤال مفارق: ما الفرق بين جحيم الحرب وجحيم العلاقة المفككة؟ وهل يستطيع الرجل الشرقي، وهو يتهاوى في المنفى، أن يتقبّل شريكةً تتحرّك بحرية لا تشبه تلك التي عرفها؟
” لقد تحررتُ يا سوار، تحررتُ أخيراً” ص٦٣
خاتمة: نحو أدب الأسئلة:
رواية “وهل من فرق؟” لا تهب إجابات، بل تنحت شكوكاً. هي رواية أسئلة الهوية، والاندماج، والرغبة، والانتماء، والانكسار الأخلاقي والمعنوي في فضاء لجوء لا يرحم. ينجح الكاتب في كتابة نصّ صادق، متحرّر من الزخرفة، متورّط حتى العظم في مساءلة الذات، واضعاً الأصبع على جرح مفتوح في راهننا الثقافي.
ورغم بعض الهفوات الفنية، والانتقائية في تمثيل الآخر، فإن هذا العمل يثبت أنّ الرواية ليست عدد الصفحات، بل عمق السؤال. إنها بداية روائية تحمل من الجرأة والصدق ما يؤهل صاحبها ليكون صوتاً واعداً في المشهد الروائي المعاصر.
- تيار الوعي: مصطلح “تيار الوعي” كنمط أدبي تم صياغته لأول مرة من قبل عالم النفس الأمريكي ويليام جيمس في عام 1890 في كتابه “مبادئ علم النفس”. ومع ذلك، لم يتم استخدام هذا المصطلح في اللغة العربية بنفس الطريقة والتوكيد اللغوي الذي استخدمه جيمس في اللغة الإنجليزية. ↩︎