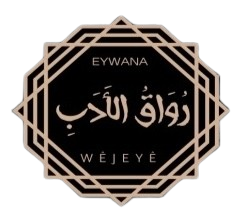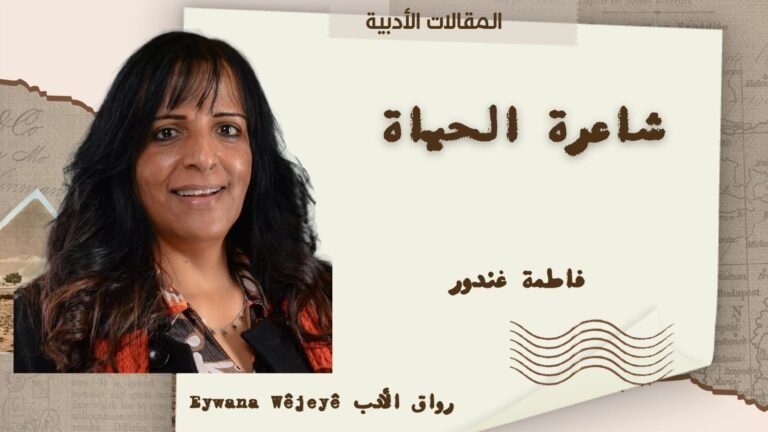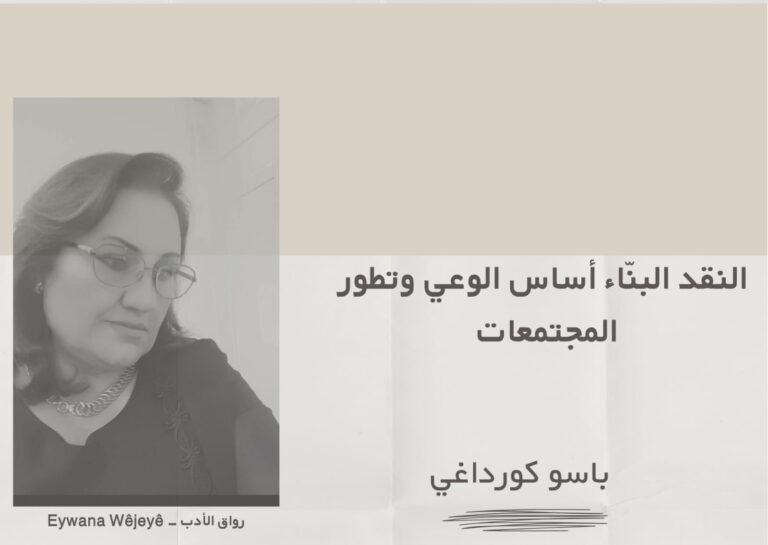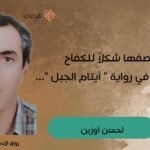مثال سليمان

افتتاحية العدد الثاني عشر من مجلة رواق الأدب،
في كل رحلة اغترابٍ، يولد داخل الكاتب وطنٌ خفي، وطنٌ بلا جغرافيا ولا خرائط، وطنٌ تسكنه الكلمات بدلاً من البشر، وتُعشِّش في فضائه الذكريات كملوكٍ أبدية تجلس على عرش الحنين. هذا الوطن ليس مكانًا يُستدلُّ عليه بالبوصلة، بل هو فضاء داخلي ينمو ويتمدَّد بقدر اتساع الغربة في الروح. الكتابة في المهجر ليست مجرد ممارسة إبداعية عابرة، ولا هي محاولة عفوية لإعادة إنتاج الذات، بل هي فعل وجودي عميق، مقاومة صامتة أمام هشاشة الانتماء وتآكل الهوية. إنها حركة معقدة تُسائل ثنائية الحضور والغياب، وتعيد صياغة معاني الوطن والغربة، لتبتكر عوالم تتجاوز الحدود التقليدية بين الزمان والمكان.
أدب المهجر، في جوهره، هو أدب البحث الدؤوب عن الذات، ولكنه ليس بحثًا مسطَّحًا أو مغلقًا. إنه بحثٌ يبدأ من الغربة عن الجغرافيا، لكنه سرعان ما يتسلَّل إلى طبقات أعمق: غربة عن اللغة التي كانت يوماً نافذة الروح، غربة عن الثقافة التي شكّلت ذاكرة الجماعة، بل وغربة عن الزمن نفسه، حين تتوقف عقارب الحنين عند لحظة وداعٍ أولى، بينما يمضي العالم نحو حاضره بغير اكتراث. كيف للكاتب، إذاً، أن يحافظ على صدق صوته الأول وهو يغوص في بحرٍ جديد من الأصوات؟ كيف يعيد بناء هويته الأدبية وهو معلّق بين هناك الذي يسكن قلبه، وهنا الذي يفرض عليه شروطه ولغته؟
الكتابة في المنافي لا تُعدّ مجرد عملية تعبيرية، إنّما أشبه بطقس وجودي يعيد هيكلة الكاتب نفسه. إنها عملية مزدوجة تحمل في طياتها ألم الفقد ومتعة الاكتشاف. فالكاتب المهجري لا يحمل فقط إرث وطنٍ غادره جسداً، بل يواجه تجربة الغربة بوصفها محركاً فكرياً وإبداعياً. في هذه المواجهة، لا يكون الاغتراب مجرد نقص أو فقدان، بل يصبح فضاءً منفتحاً لاستكشاف الأبعاد الجديدة للذات، والتفاعل مع تجارب وثقافات تنبثق من الآخر. وهكذا، تتلون نصوص الكاتب المهجري بمزيجٍ من الحنين والأسى، من الدهشة والحيرة، من الانتماء والتشظي، لتتحول إلى مرآة تعكس معاناة الإنسان الوجودية أمام فكرة الوطن واللاوطن، الحضور والغياب.
تجربة أدب المهجر ليست وليدة اللحظة، بل هي جزء من تاريخ طويل شهد خلاله الأدب محاولات دائمة لإعادة تعريف الهوية في مواجهة المنفى. من جبران خليل جبران الذي جعل من اللغة جسورًا تمتد بين الشرق والغرب، ليصوغ رؤية كونية تنبع من الخاص إلى الكوني، إلى أدباء العصر الحديث الذين يحملون حقائب ممتلئة بالأسئلة الوجودية، ويجدون في المنفى مرآةً للذات، ومساحة للتجريب والانفتاح على عوالم غير مألوفة. هؤلاء الكتّاب أدركوا أن الهوية الأدبية ليست ثابتة، بل هي كيانٌ حيٌّ ينمو ويعيد تشكيل نفسه تحت وطأة الاغتراب، ليصبح أكثر تعقيداً وغنى.
في قلب هذا الأدب، يتبدّى سؤال الهوية كمعضلة فلسفية تتجاوز الانتماء الجغرافي إلى أبعادٍ أكثر عمقًا. هل الوطن هو الأرض، أم اللغة، أم الذاكرة؟ هل يمكن للإنسان أن يعيد زرع جذوره في أرضٍ جديدة دون أن يفقد ظلال جذوره الأولى؟ أم أنّ الهوية هي حركة مستمرة، تولد من رحم الصراع بين ما نتركه خلفنا وما نواجهه أمامنا؟
في هذا العدد، نفتح نافذة على أدب المهجر، لا لنبحث عن أجوبة نهائية، بل لنغوص في أسئلة مفتوحة تطوف بين ضفاف الحنين وأفق المستقبل. نستكشف كيف شكّل الاغتراب تجربة أدبية تتجاوز حدود التجربة الفردية لتصبح مرآةً لأسئلة الإنسان الكونية. كيف أثّرت المسافات في تشكيل لغة أدبية جديدة، لغة تجمع بين أصالة الجذور وابتكار الحداثة، وتروي حكاية الإنسان الذي، وإن غادر وطنه، لم يتخلَّ يومًا عن حلمه في أن يزرع جذوره من جديد، لكن هذه المرة في تربة الكلمات، حيث لا سلطان للمنفى على الروح.