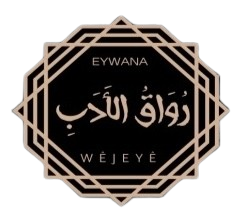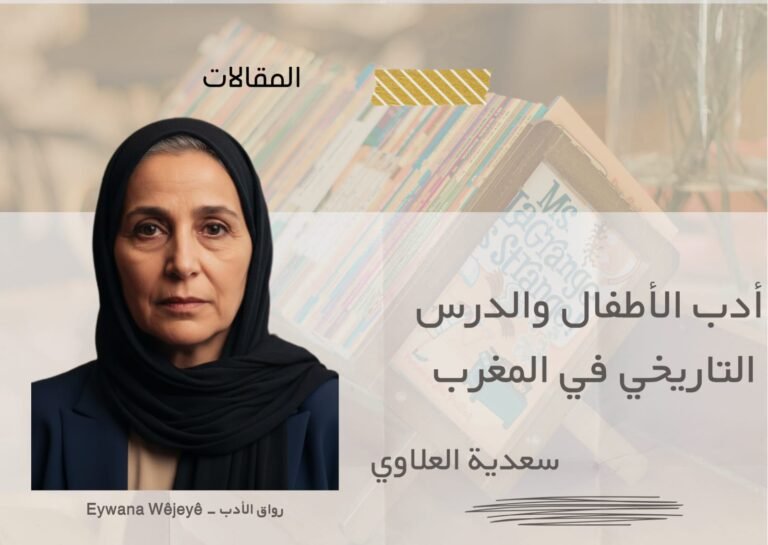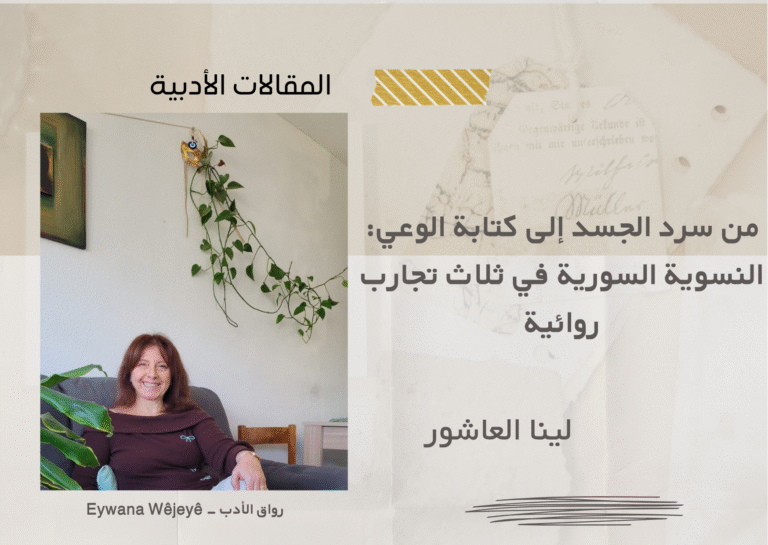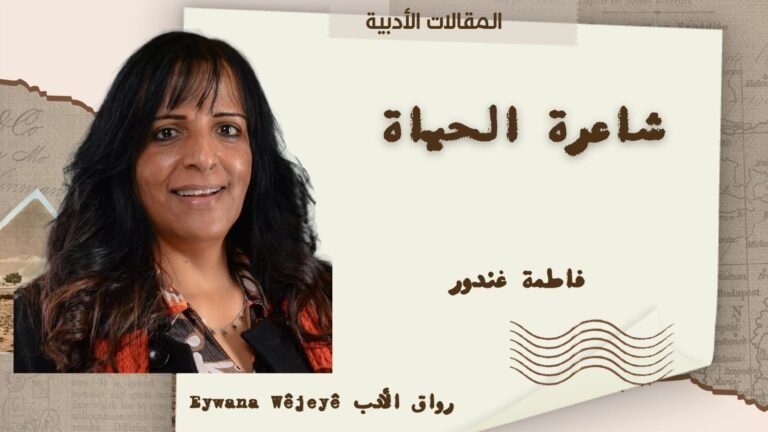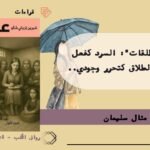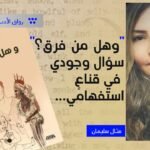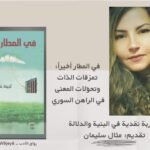إبراهيم اليوسف

عن تأثير الاغتراب والهجرة على هويتي الأدبية:
لا أتصور أنّ الكثير قد تغيّر في شخصيتي وأنا أتنقل بين اغتراب وغربة، بين مكان وأمكنة. صحيح أنني تعرفت على عوالم جديدة خلال السنوات التي مضت، وازدادت تجاربي الحياتية عمقًا، إلا أنّ للمهجر ضريبته، لا سيما بالنسبة إلى إنسانٍ قلقٍ مثلي. لم أفكر يوماً في الهجرة إلا بعد أن أصبحت في مرمى آلة الاستهداف، وبعد اعتقال واستشهاد مقربين لي.
أتذكر أنّ الصديق مشعل التمو قال لي من سجنه في مكالمة هاتفية: “أنصحك أن تغادر الوطن.” وكذلك حفيظ عبد الرحمن، الذي زرته في سجن المسلمية بحلب بعد أن نال تعذيباً قاسياً في منفردة أفقده بعض أسنانه، إذ كان الجلادون يسمعونه صوت تعذيب شخص آخر قائلين إنّه إبراهيم اليوسف. يومها قال لي: “ما الذي جاء بك؟ هيا عد إلى الإمارات!” كانت تلك المواقف بمثابة إشارات واضحة، كما خاطبتني عينا مشعل في إحدى محاكماته في القصر العدلي بدمشق، وكأنهما تستحلفانني أن أبتعد عن هذا الجحيم.
اخترت الإمارات وجهة لي، لكن الرحيل لم يمر بلا أثر. مرت فترة طويلة وكلما رأيت سيارة “ستيشن” في الشارع، ظننت أنها سيارة رجال الأمن الذين يلاحقونني أو يستدعونني للتحقيق.
في مجال الكتابة، كنت دائمًا أتنقل بين السرد والشعر. كتب لي الشاعر إسماعيل عامود ذات مرة، عندما كان يدير مجلة الثقافة الأسبوعية في دمشق، قائلاً: “أنت قاص أيضًا.” ولا تزال رسالته محفوظة في أرشيفي في الوطن. مارست الكتابة في المقال أيضًا، وكنت معروفًا ككاتب مقال، لكن ذلك جاء أحيانًا على حساب الشعر، خاصة عندما وجدت نفسي مضطرًا للدفاع عن المظلومين عبر الصحافة، وهو ما استنزف وقتًا كثيرًا من حياتي.
عندما انتقلت إلى الإمارات، عملت في القسم الثقافي بجريدة الخليج. هناك استنزف العمل الصحفي وقتي بشكل كبير، إلى جانب العلاقات اليومية مع المقربين. ومع ذلك، أعتز بما كتبته خلال تلك السنوات، رغم الملاحظات التي أسجلها على ما أُنجز آنذاك بسبب قيود العمل الصحفي. كان ذلك أول رصيد كتابي لي في هجرتي التي امتدت سبعة عشر عاماً ولا تزال مستمرة.
في مهجري الطوعي القسري، أجد وقتاً أوسع للكتابة والقراءة، لكن الحرب تظل شبحاً لا يدعنا وشأننا. واصلت مشروعي السردي، وكتبت عدداً من الروايات ونشرت أربعاً منها إلى جانب كتاب سيروي. كل ما كتبته يعكس الجانب الإنساني بين الوطن والمهجر. أميل الآن إلى السرد الصافي، متحررًا من الفانتازيا وشعريات الدرجة الأولى، مما جعلني أقرب إلى السرد الخالص. ومع ذلك، لا تزال القصيدة حاضرة في داخلي، تذكرني قائلة: “ها أنا هنا!”
إنّ الكتابة بالنسبة لي فضيلة، تجعلني في قلب الأتون، بين الناس هنا وهناك. هي جسر يصلني بذاتي وبأهلي وبالآخرين، حيث يؤدي الكاتب دوره كجزء من النخبة، سواء بالتوجه نحو محيطه أو بلفت الانتباه إلى القضايا المشتركة. أدرك أن أحفادي سيظلون هنا، في بلاد المهجر، رغم أن آباءهم وأمهاتهم، مثلي، ينتظرون ساعة العودة. خلال سنوات إقامتي هنا، استطعت أن أخلق محيطاً صغيراً من أهل المكان، وألفت انتباههم إلى أن القادمين من مواطن الحريق – الذي أشعلته القوى الكبرى وخدمها – ليسوا مجرد طالبي عيش على موائدهم.
ما أكتبه يجد صداه تدريجياً لدى الآخر، سواء عبر ترجمة إحدى مستشرقات ألمانيا لديوان لي، أو كون روايتي محور دراسة أكاديمية، أو دعوة لمحاضرة، أو المشاركة في مناقشة قضايا اللاجئين. إنه إنجاز أن تترك الكتابة أثرها رغم المسافة والفارق الثقافي.
لطالما كان فقدان المكان بالنسبة لي يشبه اليُتم. كتبت عن مدينتي، عن تل أفندي، وعن البيوت والغرف التي مررت بها، حتى أصبحت الأمكنة حضوراً دائمًا في أعمالي، سواء في رواياتي مثل: شارع الحرية، شنكالنامه، جمهورية الكلب، جرس إنذار، أو في مجموعاتي الشعرية التي صدرت في ثلاثة مجلدات. ربما تكون الكتابة إعلاناً عن أعلى درجات الحنين، لكنها أيضاً الزيت الذي يُصب على نار الشوق ليزيدها اشتعالًا. لا أعتقد أن الكتابة تخفف الألم، بل على العكس، تساهم في إبرازه، حتى وإن كانت أحياناً تخديرًا مؤقتًا.
لم يتغير شيء جوهري في موضوعاتي منذ المهجر، لكنها ازدادت اتساعًا وعمقًا. هناك أسئلة جديدة تُطرح عن الهوية، الاندماج، والتمييز بينهما. أدعو دائمًا إلى الحفاظ على اللغة الأم، خاصة بالنسبة لأطفالنا، لكن هذا تحدٍ كبير وسط طوفان عالمي يهدد الخصوصية الثقافية.
في أدبي، واصلت الكتابة عن الانتهاكات المختلفة التي تطال وطني: النظام، الفصائل المسلحة، الاحتلال، وجرائم داعش. كل هذا على حساب راحتي وخطابي الأدبي. المهجر منحنا هامشًا أكبر من الحرية، حيث يمكنني أن أقول: “يسقط الدكتاتور”، لكن القيود لم تختفِ تماماً؛ بل تغيرت ألوانها وأشكالها. هي ذاتها روح الشاعر العاصفة التي تضيق حتى بظلها.