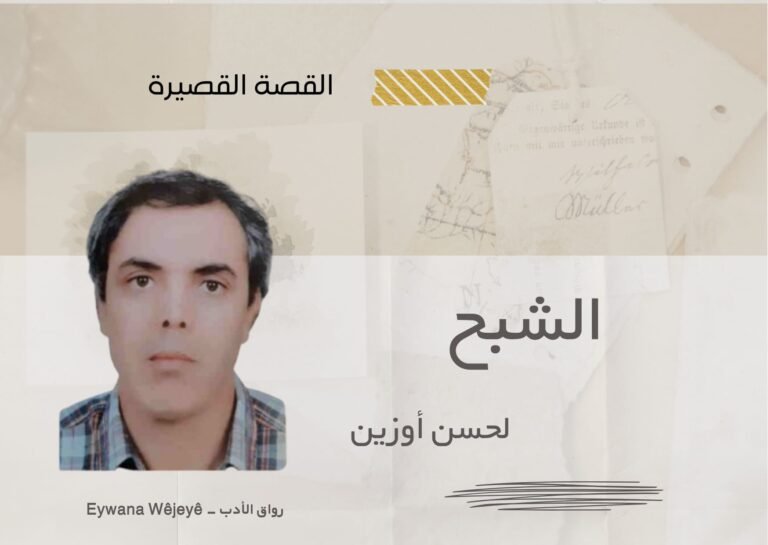لينا العاشور

الغلاف الخلفي: في زمن المنفى الرقمي، تلتقي أربع أخوات في زفاف افتراضي يكشف هشاشة روابطهن بعد القمع، المنفى، والصمت الطويل. “عرس أون لاين: ما بعد الخوف، ما قبل النسيان” تحكي عن التمزّق العائلي حين تزول أسباب التماسك القديمة.
الفصل الأول: صورة ممزقة الأطراف
وصلت الصورة عبر البريد الإلكتروني القديم، ذلك الذي لم تعد ليلى تفتحه إلا نادرًا، كأنه درج مغلق في ذاكرة أخرى.
كانت الصورة صغيرة، ذات حواف ممزقة، وممسوحة بماكينة رخيصة. أربع طفلات متقاربات في السن يقفن أمام شجرة ليمون: إحداهن تبتسم، والثانية تغمز، والثالثة تحمل دمية بلا رأس، والرابعة تنظر إلى الكاميرا كمن يشكّ في كل شيء.
على ظهر الصورة، بخط نسائي مرتجف، كُتب:
“من بقي منهن؟”
ترددت ليلى قبل أن تكتب في المجموعة المهجورة:
— بنات، شفتوا الصورة اللي بعتتها ماما؟
ثم أضافت، وكأنها تهمس إلى الغائبين:
— هل سندخل موسم أعراس أم موسم اختفاءات؟
بعد أن أرسلت الرسالة، جلست قليلًا تتأمل الشاشة الخافتة، ثم تمتمت بصوت بالكاد يُسمع:
— كم أشتاق لماما… لو يمد الله في عمرها لأتمكن من رؤيتها. نحن هنا في بلاد اللجوء، ننتظر الفرصة، ننتظر الهواء…
ضغطت على اسم لور، شقيقتها، واتصلت.
— لور، هل رأيتِ الصورة؟
— نعم، يا إلهي… هل تتذكرين عرس أخينا سمير؟
— وكأنّه كان أمس… تتذكرين كيف مشت ماما حافية القدمين في صالة الأعراس؟ كانت قد نذرت: إن تمّ زواجه، ستمشي حافية.
— طبعًا أذكر. كانت الأرض باردة ومبلولة، لكنها مشت بعينين مغمضتين وقلب مفتوح.
سكتت لور قليلًا، ثم أضافت وهي تأخذ نفسًا عميقًا:
— إن شاء الله تحضر عرس ابن زهور أيضًا.
توقفت ليلى، ثم همست ببطء:
— آه… كم اشتقت إليها.
وصمتت لحظة، وكأن شيئًا آخر يطرق باب الذكرى.
— وكم أشتاق لسمير أيضًا… تتذكرينه يا لور؟
تنهدت لور، وكأن اسمه وحده يحمل تعب العائلة كلها.
— كيف أنساه؟ هو في بلاد المغترب، مثلنا… مثل الكل.
قالت ليلى، والدمعة تسبق ضحكتها الخفيفة:
— كان يسامرنا، يمازحنا، يحمينا حتى من خلافاتنا التافهة… كان سندًا. الكلمة الطيبة كانت عنده، كأنها من قلب أب.
سكتتا معًا، كما يسكت الذين يعرفون أن ما يُقال لم يعد يصل إلى مكان إلا في ذاكرتهم.
تقطعت لحظة الصمت بسؤال لور:
— هل وصلتك الدعوة لحضور زفاف ابن زهور غدًا أونلاين؟
ردّت ليلى:
— أكيد سأحضر.
—
في اليوم التالي، الساعة تشير إلى الثامنة مساءً بتوقيت حلب. صالة الأفراح تضجّ بالصوت والضوء. الزينة الذهبية تبعث وهجًا دافئًا يوحي بالفرح. الطاولات مصفوفة بأقمشة حريرية، كأنها باقات من الورد الأبيض والذهبي. صدى الموسيقى يملأ المكان، وأغنية “يليق لك الأبيض” تندمج مع الزغاريد والأحاديث الجانبية، وضحكات الأطفال تنثر البهجة.
ظهر شاب وسيم في منتصف العشرينيات، طويل القامة، يرتدي بدلة سوداء أنيقة. إنه العريس. صرخت الأخوات عبر الشاشات:
«العريس! العريس!»
دخل مصحوبًا بعروسه: شابة ذات وجه ناعم وأنف دقيق، ترتدي فستانًا أبيض كأميرات عصر النهضة، وتغطي شعرها بتسريحة مرفوعة تُظهر عقدًا ذهبيًا يزين عنقها.
في الخلفية، كاميرا منصوبة على حامل ثلاثي تبثّ الحدث مباشرة، حيث تتابعه الأخوات الأربع من أماكنهن المتفرقة.
—
رضوة – باريس
جلست في مطبخها، خلفها نافذة تطل على شارع رمادي في أحد أحياء ضواحي باريس. تمسك كوبًا من القهوة وتعلق بصوت خافت، متظاهرة بالتفهّم:
— شايفين كيف العرس صار هيك… سريع، ما شاء الله. الله يهنيهم.
ثم أضافت هامسة:
— زهور لازم تفرح… خلص.
حاولت إخفاء دمعة سقطت فجأة.
—
ليلى – ليون
تظهر في غرفة أنيقة، مرتبة بعناية. يمر أولادها في الخلفية، يلقون التحية على الشاشة ويبتسمون. تقول بحماس:
— يا سلام، ما أحلى العروس! متل القمر والله… شايفين؟
ثم تنظر نحو ابنها وتتمتم:
— عقبال عندك يا رب.
—
لور – كندا
وهي مستلقية على أريكة، تتكئ على وسادة، وخلفها صور لأولادها معلقة على الجدار. تقول متأثرة:
— حاسة إني عم شوف فيلم، بس قلبي هناك، في الضفة الأخرى من العالم…
تتنهد:
— بتذكّر لما كنا زمان، مع أخواتنا الشباب وماما، نرقص بعرس بنت زهور، نمسك إيدين بعض، ونحضن ماما…
ثم تكمل بصوت متهدج:
— متى رح ترجع هديك الأيام؟
—
زهور – حلب
تتنقّل بين الطاولات، تحمل الهاتف وتبتسم مثل فراشة، تردد بفرح:
— سمعتكم كلكم! رضوة حبيبتي، عقبال بنتك يا رب… فعلاً الأيام تركض!
ثم تضيف:
— بتتذكري يا رضوة عرس بنتي؟ وقت كنا كلنا سوا؟ هلق بنتها بالإعدادية!
ليلى تردّ بلهجة حنونة:
— الله يحفظها… لور، قلبنا معك.
لور تضحك رغم التأثر، تخفي دمعة وتنظر للشاشة على أنغام موسيقى صباح فخري.
—
في الخارج، تنقل الأخبار توترًا أمنيًا، أصوات طائرات تحلق من وقت لآخر، وأحيانًا يُسمع دويّ قصف. رغم ذلك، داخل الصالة، الفرح لا يزال قائمًا.
ينتهي البث على مشهد العروسين يرقصان على أنغام أغنية “حلوة يا بلدي”. يتعالى التصفيق، ثم يسود صمت قصير على الشاشات.
كل أخت تحدّق في الشاشة، وكأنها تبحث عن نفسها في ذلك العرس البعيد.
تكسّر ليلى الصمت:
— يمكن ما اجتمعنا بالجسد، بس هاللحظات جمعت قلوبنا.
تمسح رضوة دمعة خلف نظارتها. تحاول ألا يلاحظ أحد حركتها، لكن لور تلتفت فجأة وتسأل:
— رضوة، عم تبكي؟
— لا… شويّة غبار.
لكن لم يكن غبارًا. كان وجعًا دفينًا.
رضوة لم تبكِ لأنها لم تحضر جسديًا، بل لأن عرس ابنتها سيُقام بعد شهر في باريس، في حفل صغير، شبه سري، بلا عائلة، بلا زغاريد، بلا أخوات.
الأصعب من ذلك: ابنتها لم تدعُ أحدًا من العائلة.
ربما هناك ما تخفيه رضوة عنهن.
تتظاهر بالغناء مع الأغنية، وفي داخلها صوت يصرخ: “ما بدي حدا بعرس بنتي… تعبت من الأسئلة: كم عمر الشب؟ قديش خاتم الخطوبة؟ ليش استعجلتوا؟
ربّيت بنتي وحدي… هي ديني المُسدَّد. أمل حياتي. نجاحي الوحيد أمام الكل.”
تضغط بأصابعها على عينيها كي لا يرى أحد دموعها، وتقول بخفوت:
— مبروك للعروسين…
ليلى تلاحظ شيئًا خلف الكلمات وتسألها برفق:
— إنتِ بخير؟
— أي… العرس حلو.
ثم تنسحب رضوة من الحفل الإلكتروني فجأة:
— بدي آخد حبة دواء.
تغلق الكاميرا دون أن تنتظر رد أحد
الفصل الثاني: بين التغريدة والبث المنقطع
إلى المطبخ لتعد كوبًا من الشاي الأخضر. أمسكت الكوب بيدها، واتكأت على حافة السرير، تمسك هاتفها كما لو أنه شيء غريب سقط من السماء.
أعادت الاستماع إلى التسجيل الصوتي من أختها. بدا الصوت غريبًا، باردًا، خاليًا من العواطف. كان هادئًا أكثر من اللازم، وكأنّه يخفي شيئًا… أو لعله فقط تعب من الكلام. “أنا أود دعوتك إلى حفلة زفاف ابني، أون لاين، مساء يوم الاثنين من شهر آب 2024.”
توقف قلب رضوة للحظة. جزء من الثانية فقط، لكنه كان كافيًا.
ثم تابعت زهور، بصوت متهدج:
“الله يلعن الغربة… كل أخواتي في الغربة، وأنا وحدي هنا!!”
نهضت رضوة ببطء من على الكرسي، وسارت نحو غرفة النوم التي لا يفصلها عن المطبخ سوى عتبة خشبية باهتة. كانت شقتها الباريسية صغيرة، تمامًا ككثير من أحلامها. الجدران رمادية شاحبة، حاولت أن تبث فيها الحياة بصور قديمة مؤطّرة، لكنها بقيت باردة… كأن الغربة نفسها قد تسللت إلى الطلاء.
عادت إلى الغرفة بخطى بطيئة. كل شيء فيها كان مرتبًا أكثر من اللازم: سرير مشدود الأطراف، شرشف أبيض مطوي بعناية، وسادة وحيدة موضوعة في المنتصف كجندي في استعراض.
جلست على السرير، نصف مستلقية، دون أن تنظر إلى شيء محدد. مدت يدها لتمسح دمعة باغتتها.
نظرت إلى النافذة المقابلة لها: لا ستائر، لا قمر، لا ضوء…
فقط انعكاس وجهها المتعب على زجاج النافذة.
الصالون بدا واضحًا خلفها، مفتوحًا على مطبخ صغير مزين بأدوات مرتبة كأن أحدًا لا يستخدمها.
الضوء الخافت المنبعث من مصباح معلّق فوق الطاولة جعل المكان يبدو كلوحة مأزومة، مشدودة بين الحياة والسكون.
كل شيء جامد.
كان الدفء الوحيد في الشقة هو لون الخشب الداكن لمكتبٍ مركون في الزاوية، لكنه لم يكن كافيًا لطرد هذا البرد العميق الذي يسكنها.
ساد الصمت، صمت قاتل.
لا صوت سوى ارتجاف أنفاسها. حتى الثلاجة، التي كانت تئن كل مساء، صمتت هذه الليلة… كأنها تشاركها المأتم.
نظرت رضوة إلى الفراغ أمامها، وهمست بصوت لا يسمعه أحد:
“هنا، على هذا السرير، تنتهي كل الغربة…”
ابتسمت بخفة، لكن الغربة لم تنتهِ.
مدّت جسدها ببطء على السرير، دون أن تخلع ثيابها التي حضرت بها الزفاف الافتراضي، كأنها لا تريد للدفء أن يربك وحدتها.
أغمضت عينيها، وفي الأفق، خلف الجدران، سمعت زغرودة بعيدة…
زغرودة لم تأتِ من الآن، بل من ذاكرة قديمة.
أوف… كأن البث لم تكتمل فيه القصيدة
الفصل الثالث : أنتِ مو غلطتي
استلقت على السرير بكامل جسدها.
تراءت لها صورة سهى، ابنتها، ترتدي فستان الزفاف.
“آه… بعد شهر فقط.”
توقّف شريط الذاكرة فجأة.
ظهرت سهى في ذهنها داخل حفلة صاخبة مع خطيبها، والضحكات تتعالى من كل زاوية. على هاتفها، ما تزال صور “بروفة” فستان الزفاف تتوالى، أرسلتها سهى بحماسة عبر الواتساب.
قلبت الصور بسرعة ثم رمت الهاتف على طرف الطاولة.
مدّت يدها تبحث في أوراق قديمة، أو في زوايا ذاكرتها، أو بين فواتير متراكمة على مكتبها.
وفي لحظة، لم تعد تفكر بشيء.
وهذا ما أزعجها أكثر من التفكير نفسه.
رنّ الهاتف. النغمة المختارة كانت لشارل أزنافور:
“Know the time will come
When you’ll be taken from me.”
ارتعش قلبها. إنها سهى.
الأصوات كانت عالية في الخلفية، ضحك، موسيقى، حياة.
– “ماما، رح أرجع بعد شوي…”
تماسكت رضوة. ارتدت جاكيت خفيفًا فوق بيجامتها وخرجت إلى البلكونة.
الليل يرخي خيوطه، لا يُرى منه سوى ظلال الأغصان الكسلى تميل فوق السياج البعيد. الهواء البارد توقّف داخلها أكثر مما حرّكها. كان شيئًا دفنته طويلًا… شيء يشبه الحياة.
فصل الرابع : البلكون
رمقت الشارع في الأسفل بنظرة ساكنة.
كان هو الحياة التي تفتقدها، هناك، في الخارج.
في الداخل، كانت فقط تتنفس.
الأصوات المتعالية تتسلل من مقهى في الزاوية، تذكّرتها.
نعم… في إحدى أمسيات الشتاء الرمادية، جلست هناك وحدها في مقهى صغير. كانت تحتمي بفنجان قهوة من البرد، وقالت في نفسها يومها:
“قالوا الثورة أمّ التضحيات… بس ما قالوا إنو الأم تولّد لحالها، وتربّي لحالها، وتكذّب على الناس لتعيش… وتضلّ تخاف، وتضلّ تسكت.”
في قلبها، كانت تحمل تاريخًا طويلاً من الوحدة، الخوف، الذنب.
تذكّرت:
قبل اثنين وثلاثين عامًا، هنا في باريس،
في حقيبتها كانت تحمل ملفًا طبيًا، نسخة ممزقة من جواز سفر، وصورة باهتة لرجل لم يترك رقمًا، ولا وعدًا.
دخلت المستشفى الحكومي بصمت. ادّعت أنها لاجئة، بلا تأمين، بلا سند.
قالوا لها إن الولادة ستكون سهلة،
لكنها كانت تكذب.
حين ولدت سهى، بكت. لا فرحًا، بل وجعًا.
صرخت داخلها: “وينهم؟ وين أمي؟ وين إخوتي؟”
خرجت بعد أيام إلى شقة صغيرة بلا مصعد، بلا أصدقاء.
مرت سنواتها الأولى في خوف دائم: من الشرطة، من الخدمات الاجتماعية، من الذكريات.
لكن حين كانت تنظر إلى سهى، كانت تقول:
“راح أكبرك… وراح تكوني أحسن منهم كلهم.”
…
رنّ صوت المفتاح في الباب،
عادت سهى، والفرحة لا تسعها.
نظرت رضوة في عيني ابنتها، وقالت بصوت أثقل من أي لوم:
– “كل مرة بتحكيلي إنك عشتِ حرمان، وإنك محرومة من أب، ومن استقرار، كأنك عم تحاسبيني.
بس إنتِ مو غلطتي. إنتِ نتيجة معركة أنا خضتها لحالي… وأنا دفعت التمن.”
ساد صمت كثيف.
ثم تكلمت سهى بصوت خافت:
– “بس أنا دفعت تمن كمان.”
مشت رضوة نحو النافذة، فتحتها قليلًا.
هواء باريس البارد دخل الغرفة كأنه كفّ ماء على وجه ساخن.
أرادت أن تقول: “كنت صغيرة ومضغوطة”… أو “عملت اللي قدرت عليه”.
لكنها عرفت أن هذه الجمل لا تنفع. لم تكن تنفع يومًا.
قالت بهدوء:
– “إذا بدك تتركي شي وراكي اليوم، خلي يكون اللوم. لا تحمليه معك، ولا تورثيني إياه.”
…
كانت رسائل الواتساب تتوالى،
تنظر بطرف عينها…
إنها ليلى.
ثم لور.
ثم
الفصل الخامس: غرف مغلقة، نوافذ مفتوحة
في نافذة الزووم، انعكست صورهنّ الثلاث — وجوه تعبق بالضوء، يلمع فيها أثر من زمن قديم.
كان يُفترض أن تكون جلسة تنسيق أخيرة للعرس، لكن شيئًا ما تغيّر.
الوقت انسحب من بين الأصابع، وفتح الباب لذاكرة كانت تنتظر من يطرقها.
قالت ليلى، وضحكت ضحكة قصيرة تعرفها أخواتها جيدًا:
«تتذكرون الصيف اللي غرقنا فيه الحوش بالمي؟ ماما كانت راجعة من الشغل ولقاتنا نسبح بلباس المدرسة!»
انفجرت ضحكة زهور، خفيفة، كأنها طائرة ورقية أفلتت من يدها:
«وأنا كنت أغرق! وأنتم تضحكون عليّ!»
تدخلت لور من بعيد، من خلف جدار لهجتها الحلبية التي لم تغادرها:
«وماما… كان قلبها ضعيف علينا، تصرخ وبعدين تبكي، ما كانت تقدر تكمل العقاب.»
في خلفية الشاشة، مرّت ابنة رضوة، سريعة، مستعجلة كعادتها.
كان وجه رضوة في الزاوية، مظلّلًا. لم تتكلم.
كانت هناك، لكنها لم تكن.
ليلى شعرت بذلك — أكثر مما رأته.
لكنها اختارت ألا تقترب من الجرح، بعد أن لدغها مرارًا.
فبدلًا من ذلك، قالت بنبرة دافئة:
«أكتر شي افتقدته هون هو لمّة الجمعة، ريحة الطبخ، صوت ماما تدعي لنا بالستر… حتى لما عشنا الفقر، كنا مع بعض.»
أومأت لور من شرفتها المطلة على بلد بعيد:
«الغربة مش دايمًا المكان… أحيانًا الغربة بتبدأ جوّاتنا.»
أما زهور، فكانت ما تزال في نشوة انتهاء الزفاف بنجاح، وكأنها تنقذ الجميع من الشجن:
«والله يا أخواتي، الفساتين طلعوا روعة! اللون السماوي مع اللمعة الفضية؟ تحفة! والعروس كانت تطير من الفرح! وبشهر العسل؟ تخيّلوا! الجبل والبحر في نفس الصورة!»
ليلى ردّت بدفء:
«تستاهلي يا زهور، تعبك ما راح هدر.»
لور أرسلت قلبًا في الدردشة.
ورضوة… لم تكتب شيئًا.
في غرفتها الباريسية، الضيقة والخالية، جلست قرب شاشة الكمبيوتر، تنظر إليهن كما لو كنّ فيلمًا قديمًا.
ذاكرتها كانت مختلفة.
ليست تلك الضحكة، بل صراخ في الليل.
ليست رائحة الطبخ، بل رائحة الدم حين اقتيد آخر ناشط من الحي.
ليست لمّة الجمعة، بل خوف أمها من الطرد يوم عرفت أنها حامل.
كانت وحيدة، خائفة، تخبئ همّها في صمتها كي لا تقلق الباقين
تركتْ الكاميرا مفتوحة دون أن تنتبه.
ظلّت الشاشة تعرض وجوه الأخوات الثلاث، يتبادلن الابتسام والنكات، وهنّ لا يعلمن أن رضوة تراهن دون أن تشارك.
كان الضوء الخافت يتسلّل من نافذة خلفية، ينعكس على وجهها الباهت. جلسَت بلا حركة، كتفها مستندة إلى حافة الكنبة، وذقنها تميل قليلًا نحو صدرها كأنها تزن ما تبقّى من صبر. في الزاوية المقابلة، علّقت مرآة صغيرة لا تكاد تُرى، لكن في تلك اللحظة، كانت ترصدها بدقة لا ترحم.
صورتها المنعكسة بدت كأنها شخصٌ آخر… امرأة تطلّ من غرفة مغلقة، تراقب نفسها وهي تغرق في الصمت.
تقوم بهدوء، تُغلق الستائر برفقٍ متعمد، كأنها تحكم الشيش الداخلي على قلبها لا على النافذة.
تعود إلى الشاشة.
الصوت يتلاشى تدريجيًا، كما لو أن الذاكرة نفسها تلفظ أنفاسها الأخيرة.
تغلق الجهاز.
تبقى لحظة واقفة أمام النافذة.
الستائر لا تزال تنفث ما تبقّى من الضوء.
ترفعها قليلًا، تفتحه على آخره.
هواء باريس يدخل بلا خجل، يعصف بشيء ما في الداخل.
هي لا تقف في غرفة…
إنها تقف في هشاشتها، تنظر من نوافذها المفتوحة.
نادت على سهى، وجلستا تتأملان بعضهما، عينا بعين.
قالت رضوة بفخر ناعم:
«صرتِ موظفة قد الدنيا يا سهى. وخطيبك من جنسية أجنبية، ومعاه شهادة عليا. كل العيلة بتغار منّا. شايفة؟ هذا النجاح… هو شهادة إنّي نجحت، رغم كل شيء.»
ابتسمت سهى، ثم قالت بتردد:
«ماما… ما بقي شي على حفل الزفاف! شهر بس…»
لكن القلق كان قد بدأ يحفر خطوطه على جبين رضوة.
كان هناك سرّ كبير يخيم على قلبها: ابنتها حامل. ولم تخبر أحدًا من أخواتها.
دخلت إلى المطبخ مسرعة، وقد شمّت رائحة الشوربة التي تركتها على النار.
استنشقت الكمّون الذي عبق في البيت… شيء ما تغيّر في الهواء.
الفصل السادس: إلغاء الدعوة لحضور الأقرباء
كنّ ينتظرنَ تأكيد الدعوة لحضور زفاف سهى. في الغربة، كانت كلّ واحدة تمسح شاشة هاتفها مرارًا، كأنها تهيّئ المكان لرسالة الفرح. لكنّ ما وصل لم يكن ما توقّعن.
رسالة قصيرة. باردة.
“أعتذر. لا يمكننا استضافتكنّ. الظروف ضاغطة. سنرسل الصور لاحقًا.”
الفصل السادس: إلغاء الدعوة لحضور الأقرباء
كنّ ينتظرن تأكيد الدعوة لحضور زفاف سهى.
في الغربة، كانت كلّ واحدة تمسح شاشة هاتفها مرارًا، كأنها تهيّئ الزجاج لعبور الفرح.
لكن الذي وصل لم يكن فرحًا.
رسالة قصيرة، باردة، كأنها أُرسلت من جهاز لا يعرف صاحبه الحبّ:
“أعتذر. لا يمكننا استضافتكنّ. الظروف ضاغطة. سنرسل الصور لاحقًا.”
فتحت ليلى التسجيل الصوتي.
أرسلت بصوت دافئ، مرتبك، متردّد:
“سهى، حبيبتي… مبارك. بس ما فهمنا… ليه؟ شو صار؟”
صوتها ظلّ معلّقًا في الهواء.
تبعته تسجيلات أخرى، أطول، أدفأ، حائرة.
لكن لا جواب. لا حتى كلمة.
أرسلت لرضوة، أخيرًا:
“ردّي عليّ… مش للوم. بس بدي أفهم.”
كأن الإنترنت تجمّد.
الرسائل تراكمت كما يتراكم الغبار على زجاج النوافذ المغلقة.
لا أحد يقرأ، لا أحد يمسح، ولا حتى يحذف.
ثم، بعد أيام من الصمت، وصلت رسالة واحدة.
جملة واحدة، كأنها قُطعت من حجر:
“نحن بخير… دونكم.”
—
بعد ستة أشهر، كانت رضوة تجلس بجوار النافذة، في منزل سهى الزوجي، بإحدى ضواحي باريس.
تلمس وجنتي ابنتها، التي كانت في شهورها الأخيرة من الحمل.
“كيف الجنين يا حلوتي؟”
ضحكت سهى:
“عنيف. يخبط ويلبط كأنه يريد الخروج بالعنف.”
رضوة قلّبت صور الألبومات في هاتفها. لم تكن تبحث عن شيء بعينه، لكن عيناها وقعتا على صور عرس زهور، الذي سبق زفاف سهى بشهر. العرس الأونلاين، العرس البعيد.
حدّقت في الصور. وجوه أخواتها، زهور تضحك، لور تلوّح، ليلى تنظر في الكاميرا بعينين دامعتين.
لكن… صورتها لم تكن هناك.
كأنها كانت غائبة عن العرس، عن الحكاية، عن ذاكرة اللحظة.
بحثت عن أثر لوجودها، حتى وإن كانت صورة مشوّشة، حتى ظلّ على الزجاج. لا شيء.
“ماما؟” قالت سهى، “بدي شي سخن… انظري إليّ، الجنين عم يطلع، قربت أولد.”
رضوة ابتسمت ابتسامة منسية، ونهضت كأنها تمشي على جمر.
كانت تعرف أن سهى لم تعد تخفي حملها عن العالم. لم تخجل هي من ابنتها، بل من العالم… من تناقضاته.
من الأحكام. من التجارب التي تُعاش وتُحكم في الوقت ذاته.
هي، رضوة، مرّت بكل ذلك. وعاشت تناقضاته.
تذكّرت ليلى، تذكّرت لور. كل واحدة منهما عاشت حياتها كما أرادت – أو كما قُدّر لها.
أما هي، فقد بقيت بين الفجوة: ما تُحب، وما يحدث.
تنتمي لذلك الطيف من النساء اللواتي لا يعرفن تمامًا كيف يُصلحن العلاقة بين الرغبة والواقع.
قالت لنفسها:
“قلبي لم يعد يتسع للوم آخر… حتى لو لم يُقال بصوت عالٍ.”
فتحت الواتساب، مرّت فوق أسماء زهور، ليلى، لور، بعض الأصدقاء.
ثم أغلقت الهاتف، بصمت.
لم يبقَ شيء.
فقط الرسائل المحذوفة
20_5_2025