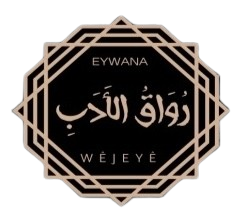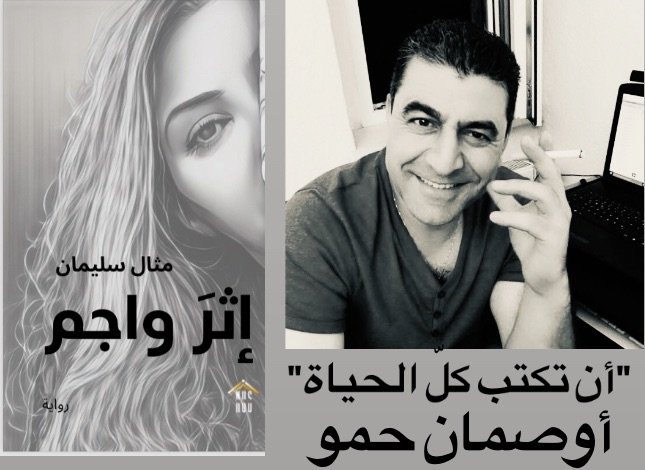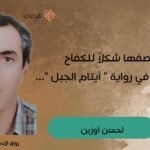لينا العاشور

مقدمة الغلاف
مع كل جولة يومية على منصّات التواصل الاجتماعي، يتضح تحوّل لافت في سلوك المستخدمين: تراجع حاد في التفاعل، خصوصًا على مستوى التعليقات أو حتى أبسط أشكال التفاعل الرمزي مثل “الإعجاب”. يكاد هذا الحضور يقتصر اليوم على كلمات تعزية مقتضبة لمن فقد قريبًا، فيما تختفي النقاشات التي كانت في السابق تشتعل تحت المنشورات. عند هذه الملاحظة يبرز السؤال: ما الذي تغيّر؟
مدخل افتتاحي أدبي
في مقهى صغير على أطراف المدينة، يجلس رجل يراقب هاتفه. يلمع إشعار جديد على الشاشة: “تعليق على منشورك”. يبتسم نصف ابتسامة قبل أن يقرأ، لكن الملامح سرعان ما تنطفئ. كلمات جارحة، سخرية لاذعة، واتهامات لا علاقة لها بما كتب. يضع الهاتف على الطاولة كما يضع كاتب قلمه بعد ليلة شاقة من العبث، ويتمتم: “لم يكن هذا هو الحوار الذي حلمنا به حين انفتح العالم”.
منذ أن فتحت المنصات الرقمية أبوابها للجميع، تسلّل إليها كل شيء: الفكرة اللامعة والشتيمة العابرة، النقاش العميق والنكتة السمجة، التحليل الرصين والخبر الكاذب. في هذا الفضاء المتشابك، حيث يتساوى صوت الباحث مع ضجيج المارّة، اختار كثير من النخب الثقافية والدينية الصمت أو الانسحاب. ليس خوفًا من الرأي الآخر، بل تجنّبًا لسوقٍ يعلو فيه الصراخ على الفكرة، وتُستبدل فيه الحكمة بالشعار.
تراجع النخب الثقافية والدينية من الفضاء الرقمي: بين ديمقراطية الاتصال وشعبوية الخطاب
المقدمة
شهد العقدان الأخيران تحوّلًا جذريًا في البنية الاتصالية للمجتمعات، بفعل الانتشار الواسع لمنصّات التواصل الاجتماعي، التي جعلت الكلمة المكتوبة والمصوّرة في متناول أي فرد يمتلك هاتفًا ذكيًا واتصالًا بالإنترنت. هذه “دمقرطة الاتصال”، رغم طابعها التحرري، حملت معها تحديات عميقة للنخب الثقافية والدينية، التي كانت فيما مضى تتمتع بوسائط تقليدية تضبط علاقتها بالجمهور، مثل الصحافة الورقية أو المنابر الأكاديمية والدينية المنظمة.
لكن مع الانتقال إلى الفضاء الرقمي المفتوح، وجدت هذه النخب نفسها أمام بيئة يغلب عليها الخطاب الشعبوي والانفعالي، ما دفع الكثير منها إلى الانسحاب أو تقليص حضورها.
المنهج المتّبع: في هذه المقالة نعتمد مقاربة سوسيولوجية–تحليلية، تزاوج بين قراءة تحولات الفضاء الرقمي بوصفه بنية اجتماعية–اتصالية، وبين رصد انعكاسها على موقع ودور النخب الثقافية والدينية في المجال العام.
الإطار النظري
1- المجال العام عند هابرماس
يعرّف يورغن هابرماس المجال العام بأنه فضاء للنقاش العقلاني الذي يتيح للمواطنين التداول حول الشأن العام بعيدًا عن ضغوط الدولة والسوق. غير أن الفضاء الرقمي، برغم تشابهه في بعض جوانبه مع هذا النموذج، يبتعد عنه في نقاط أساسية:
تغليب الانفعال على العقلانية.
اختصار النقاش في عبارات وجمل قصيرة.
غياب الضبط المؤسساتي الذي يحمي جودة الحوار.
وبالتالي فإن ما نشهده اليوم ليس توسيعًا للمجال العام بقدر ما هو تفكك له، حيث تنزاح النقاشات من التحليل إلى المزايدات، ومن الحاجة إلى الصراخ.
العرض
دمقرطة الاتصال وانحسار دور الوسيط
ألغى الفضاء الرقمي معظم أشكال الوساطة التقليدية التي كانت تمنح الخطاب النخبوي وزنًا خاصًا. لم يعد المقال المتخصص أو الخطبة العلمية يمرّ عبر محرر أو لجنة مراجعة، بل صار يُنشر مباشرة إلى فضاء مفتوح، حيث تُقابل الأفكار بردود آنية ومفتقرة للسياق.
وقد عبّر الفيلسوف الإيطالي أمبرتو إيكو عن هذه الظاهرة بحدة، قائلًا:
“وسائل التواصل الاجتماعي منحت جيوشًا من الحمقى حق الكلام، تمامًا كما يُمنح للحائزين على جائزة نوبل”
في إشارة إلى تآكل الفوارق بين المعرفة المتخصصة والرأي العابر، وهو ما جعل كثيرًا من المثقفين ينكفئون عن المشاركة، تاركين الساحة مفتوحة أمام الأصوات الشعبوية.
2- شعبوية الخطاب وتآكل العمق
إذا كان الفضاء الرقمي قد أتاح حرية الوصول والنشر، فإنه في المقابل رسّخ أنماطًا من الخطاب تقوم على الإثارة والاختزال. فقد بات “الترند” معيارًا مركزيًا لتقييم حضور أي فكرة أو صاحبها، حتى لو كان المضمون فقيرًا. هذا التحوّل جعل النقاشات العميقة تبدو خارج الإيقاع السريع للمنصات، فاستُبدلت الحجج الرصينة بالشعارات والردود السطحية.
النتيجة أن المثقف الذي كان يجد في مقالة طويلة أو محاضرة أكاديمية وسيلة للتأثير، صار يواجه جمهورًا يفضّل مقطعًا قصيرًا أو صورة ساخرة. وهنا يتقلص مجال الفعل النخبوي لصالح أنماط خطابية تبسط المعقد وتستثير الانفعالات، لا التفكير النقدي.
بهذا يمكن فهم صمت كثير من النخب لا كعزوف فردي، بل كأثر بنيوي لبيئة تهيمن عليها الشعبوية الرقمية.
3- الانسحاب كخسارة متبادلة
إن تراجع النخب عن المشاركة في النقاش الرقمي لا يعني فقط خسارتها لمنبر واسع، بل يعني أيضًا خسارة المجتمعات لجزء من الرصيد المعرفي والخبرة التي كانت تضبط النقاش العام. صحيح أن الصخب الرقمي قد ينفّر المثقف، لكن الغياب الطويل يترك فراغًا تملؤه أصوات غير مؤهلة، ما يزيد من هشاشة المجال العام.
وعليه، فإن الإشكال لا يُختزل في “سوء استخدام المنصات” فقط، بل في غياب إستراتيجيات جديدة تمكّن النخب من التكيّف مع طبيعة الفضاء الرقمي بدلًا من الانسحاب منه.
خاتمة
يبدو أن التحول الرقمي لم يغيّر فقط في أدوات التعبير، بل أعاد تشكيل موازين القوة في المجال العام. بين ديمقراطية الاتصال التي أتاحت للجميع حق الكلام، وشعبوية الخطاب التي همّشت العمق، تاهت النخب بين خيارين: الصمت أو المشاركة في لعبة غير مألوفة لها.
وربما تكمن المعضلة في أن هذه النخب لم تطوّر بعد لغة جديدة تلائم شروط العصر الرقمي، فتظل أسيرة الحنين إلى وسائط تقليدية فقدت بريقها. المستقبل إذن مرهون بقدرتها على إعادة تعريف دورها: كيف تحافظ على العمق، دون أن تنقطع عن جمهور يعيش اليوم داخل شاشة هاتفه؟
المصادر
Habermas, Jürgen. The Structural Transformation of the Public Sphere. MIT Press, 1989.
Bourdieu, Pierre. Language and Symbolic Power. Harvard University Press, 1991.
أمبرتو إيكو: تصريحات صحفية حول وسائل التواصل الاجتماعي، 2015.
كتاب المباني الفكرية لوسائل التواصل الاجتماعي. موقع مكتبة المعارف الإسلامية.